د. علي ضاهر - مونتريال
هذه المقالة امتدادٌ لسابقتها التي تناولت مأزق العلاقة بين الآباء والأبناء حين يقتحم القضاء البيت ليجلس على رأس الطاولة كما لو كان كبير العائلة ويبدأ بتوزيع الأدوار: أنت ضحية، أنت جلّاد اما أنت فشاهد "ما شافش حاجة" حسب مسرحية عادل إمام، فيتحول المنزل الى محكمةً مُصغّرة، تختفي منها العواطف فتبقى الأوراق الرسمية التي تتُساقط على رؤوس الجميع.
المقالة السابقة تناولت قصة الأب الذي أراد، حسب اجتهاده الأبوي، أن يحمي ابنته من حماقة صغيرة، فإذا بالقانون يجرّه من ذراعه نحو قفص الاتهام. أما اليوم فنمشي على حدّ سكين مرصع بالتساؤلات التالية: هل ما زال الأولاد يحترمون أهلهم؟ ام أصبح على الأهل تربية أولادهم بالتنسيق مع محامٍ لاستشارته قانونيا قبل الطلب من ابنهم ترتيب غرفته؟
أقول هذا بعدما صادفتُ خبرين من بلدين مختلفين: أستراليا والسعودية. من بلد يتمشى فيه الكنغر الى بلد آخر يتحمل فيه المواطن عبء اهدار الثروات، لإرضاء غرور زعيمه، كما تتحمل الجمال العطش الشديد لفترات طوال. بلدان لا يجتمعان لا في العادات ولا في البيئة ولا حتى في شكل الفطور الصباحي، لكنهما يلتقيان في مكان واحد: ساحة القضاء، حيث أصبح الأبناء يجرّجرون أهلهم إلى المحاكم كما يُجرّجر المخالف سياسيا إلى ساحة جز الرأس في بعض البلدان!
في أستراليا: قامت فتاةٌ برفع دعوى ضد والديها لأنهما نشرا صور طفولتها. صور قالت إنها دمّرت حياتها الاجتماعية، والحقيقة أن الطفلة في الصور كانت مثل كل الأطفال: وجه مدهون ببودرة الأطفال وابتسامة نصف نائمة. لكنها في منطقها ترى أن الوالدين كان عليهما أن يطلبا منها إذنًا خطيًا قبل التقاط الصورة، وهي في عمرٍ لا تستطيع فيه النظر الا الى زجاجة الحليب!
في السعودية: تجرأ سياسيّ بمقاضاة والديه لأنهما نشرا صورًا "لا تليق بمقامه السياسي". صور طفولة بريئة لم يرتكب فيها سوى خطأ واحد: أنها ظهرت للعلن قبل أن يصبح صاحبها سياسيًا يعتقد أن هيبته أهم من طفولته. والمفارقة أن هذه الصور، مهما كانت محرجة، تظل أكثر براءة من سلوكيات كثير من ساسة ذلك البلد!
لكن لندع الأمر المتعلق بسلوكيات السياسيين جانبًا، فهذه كقصص الحَيَّات لا تنتهي، ولنعد إلى علاقة الأبناء والآباء، وهو بيت القصيد من وراء كتابة هذه المقالة، فنطرح السؤال التالي: هل يحق للأطفال منع أهلهم من نشر صورهم؟ وفي المقابل: هل يحق للأهل اعتبار صور أبنائهم جزءًا من ممتلكاتهم الخاصة، ينشرونها ساعة يشاؤون؟ وهي أسئلة لم تعد تُطرح حصريًا في الغرب، حيث يخرج الطفل من الرحم ومعه نسخة من "ميثاق الحقوق والحريات"، ويقوم في سن السابعة بتحذير أمه: "حذار من نشر هذه اللقطات، فهي غير مصرح بها قانونيًا". بل أصبحت أسئلة تُطرح في كل مكان، كما ورد في خبر السياسي السعودي.
وهذه أسئلة سوف تطرح بشدة عند المهاجرين من الشرق الأوسط، العرب تحديدًا، الذين حلّوا في كندا او في بلاد الغرب وهم يحملون تراثًا مقدسًا عن علاقة الآباء بالأبناء، علاقة محكومة بآية: "فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا"، أو بوصية بولس في رسالته إلى أهل أفسس: "أطيعوا والديكم وأكرم أباك وأمك". فهؤلاء المهاجرون القادمون من ثقافة تُجرّم قول كلمة "أفّ" الى أهلهم، يجدون أنفسهم أمام جيل إذا ضايقته صورة عائلية قد يفتح "ملفًا قانونيًا" بدل أن يفتح قلبه، كما كان الحال في الماضي. فهل نحن أمام لحظة تحول انتقالية قد تُعيد صياغة العلاقة بين الأهل والأولاد وتخلق جيلا جديدا يقول لأهله: عليكم احترام مشاعري ولا تنشروا صورًا بدون إذني، وإلا...! وهنا نصل إلى الأسئلة التالية: هل نحن أمام تفكك روابط العائلة؟ أم أننا أمام إعادة تعريفها لتصبح أشبه بـشركة مساهمة، الأب يملك الأسهم الكبرى، والأم المساهم الفعّال، والأولاد يملكون حق النقض؟ أم أننا أمام جيلٍ يرى العالم كله من منظار الحقوق ولا يهمه الدفء والحنان؟
في الماضي، كانت العلاقة تُحسم بكلمة أو نظرة أو التفاتة، أما اليوم فقد صارت تُحسم عبر لوائح استدعاء وتبليغات، فتحولت العلاقة من "لا تقل لهما أفّ" إلى "لاقوني في المحكمة"، مما يضعنا أمام تساؤلات جديدة: هل مازالت العائلة بيتًا تُحسم فيه الأمور بنظرة الأب أو تنهيدة الأم، ام انها أصبحت مؤسسة قانونية تُدار بالاستدعاءات؟ وهل انتقلت فيها العلاقات من الدفء إلى البرود أم اننا نعيش ارهاصات ولادة عقد عائلي جديد؟ وهل جيل اليوم ما زال يكتفي بالاحترام، ام أصبح يطالب بالحقوق والمواثيق، واضعا، كل ما دق الكوز بالجرة، الأهل في خانة المتهمين؟ وهل دخلنا الى لحظة انتقالية يتم فيها إعادة اكتشاف معنى العائلة؟ كلها أسئلة تنتظر أجوبة!

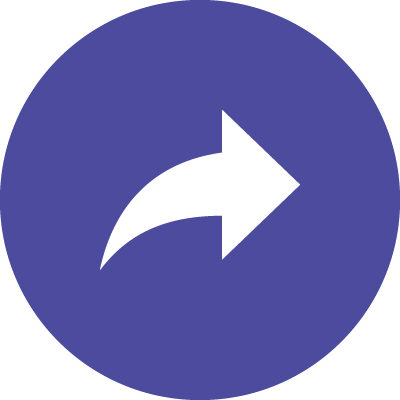




85 مشاهدة
20 ديسمبر, 2025
222 مشاهدة
19 ديسمبر, 2025
200 مشاهدة
17 ديسمبر, 2025