مونتريال- دارين حوماني
"لا يمكن لشعبنا أن يُهزم طالما أنّ هناك قوى تقاوم وترفض الخضوع. المعركة طويلة، لكنها لن تنتهي بانتصار أعداء المقاومة أو بفرض المشروع الصهيوني هيمنته على بلادنا"، يقول الكاتب والأكاديمي الدكتور طنوس شلهوب في هذا الحوار معه، وهو حوار أردنا من خلاله أن نطلّ على كتابه الجديد "قبل أن تنطفئ الذاكرة"، وهذا الكتاب هو سيرة ذاتية يعود فيها إلى سنوات النضال الأولى في سبعينيات القرن الماضي، مرورًا بمحطات من حياته، من قريته دير ميماس إلى بيروت، ثم إلى موسكو حيث أمضى عشر سنوات في دراسة الهندسة الميكانيكية، قبل أن يعود مجددًا إلى بيروت. غير أنّ الكتاب، على الرغم من كونه سيرة شخصية، هو في الوقت نفسه سيرة جماعية لمرحلة كاملة: بيروت ذلك الزمن، الحرب الأهلية، طائفيو الشعب العنيد، الجنون الأميركي، ولعنة التاريخ… زوايا يجد كلٌّ منّا نفسه في مكان منها.
.jpeg)
وطنوس شلهوب حاضر في شوارع مونتريال عند كل تظاهرة للدفاع عن العدالة الإنسانية، ومواجهة الإمبريالية الأميركية وشركائها المخفيين والمعلنين، لا بوصفه مجرّد مشارك، بل كصوتٍ مؤمنٍ بأن كرامة الإنسان أينما كان لا تتجزّأ، وأنّ واجب المرء أن يقف حيث يقف الحق.
يُشار إلى أنه سيُجرى حفل توقيع للكتاب يوم الخميس 18 كانون الأول/ ديسمبر 2025 الساعة السادسة والنصف مساء في مركز المؤسسة الفلسطينية الكندية على العنوان التالي:
845 Blvd Decarie, Suite 201, Saint- Laurent, QC H4L 3 L7
في ما يلي حوار حول الكتاب، وحول المواقف السياسية والفكرية التي عبّر عنها الدكتور شلهوب في العديد من مقالاته.
تشير في كتابك إلى أنك انخرطتَ مبكرًا في العمل السياسي داخل حزب يساري، وواصلت هذا المسار الفكري في كتاباتك ومواقفك.هل هذا الانتماء الحزب المبكر في قريتك ديرميماس الجنوبية لعبت دورًا في تشكيل وعيك السياسي، وصرت تتبنّى تحليلًا بنيويًا للعالم؟
قبل الحديث عن الانتماء الحزبي أو الالتزام السياسي، أرى أنّ ما قادني إلى العمل السياسي لم يكن الانتماء الحزبي بحدّ ذاته، بل الأدب. فقد وجدت نفسي منغمِسًا في القراءة منذ وقت مبكر، وصادف أن كان والدي قارئًا نهمًا يهتم بالأدب والسياسة والتاريخ، ويحرص دائمًا على شراء الروايات العالمية والكتب الفكرية. ومن خلال هذا الجو الأدبي بدأت رحلتي؛ إذ يمكن القول إنني دخلت باب الالتزام السياسي عبر الأدب.
ورغم أن أجواء البيت –سواء من ناحية والدتي أو والدي– كانت سياسية، فإنهما لم يحثّاني يومًا على الانتساب إلى حزب معيّن أو الالتزام بخط سياسي محدد. ولذلك كانت طريقـي إلى السياسة نابعة من الأدب ومن القراءات التي شكّلت وعيي، ثم من الصداقات والعلاقات التي نشأت خلال سنوات المدرسة مع أشخاص يشاركونني الاهتمام نفسه. هذه العلاقات دفعتني لاحقًا إلى الانخراط في حلقات التثقيف السياسي، ومنها جاء انتسابي إلى الحزب.
انتميتُ إلى الحزب في سبعينيات القرن الماضي، وكان عمري أربعة عشر عامًا. أما الانخراط الفعلي فسبقه صيفان من القراءة المكثّفة. وكان في قريتنا ديرميماس نادٍ للكتاب، وكنت أشارك فيه وأنا ما أزال في سن صغيرة. كانت القراءة المبكرة هي البوابة الأولى التي جذبتني، وعالم الكتب هو الذي فتح أمامي تدريجيًا الطريق نحو الالتزام.
كانت ديرميماس، في ذلك الوقت، ذات مناخ ثقافي واضح؛ فهناك الشيوعيون، والقوميون السوريون الاجتماعيون، كما وُجدت عائلات مرتبطة بالزعامات الإقطاعية وبآل الأسعد. غير أن الأجواء الشيوعية والقومية كانت تُعدّ الأقرب إلى الثقافة، إذ مثلت فضاءً فكريًا وعقائديًا أكثر منه اجتماعيًا أو تقليديًا. هذا المناخ لعب دوره في تكوين وعيي، رغم أن عائلتي من جهة جدي لم تكن منخرطة سياسيًا إلا بقدر محدود؛ فجدي كان عسكريًا في الجيش، وأبناؤه كانوا ميّالين إلى الشيوعية، لكن دون التزامات واسعة.
كذلك نشأتُ في جيل كان يرى في القراءة والدراسة طريقًا للترقّي الاجتماعي، وهذا العامل أسهم بدوره في دفع الكثيرين نحو الاهتمام المعرفي، وإن لم يؤدِّ بالضرورة إلى التزام حزبي. أما بالنسبة إليّ، فقد اجتمع تأثير القراءة من جهة، وأجواء البيت من جهة ثانية، مع حضور الصحافة الحزبية في حياتنا؛ فقد كانت تصلنا أسبوعيًا جريدة الأخبار، وكان لها أثر كبير في تعميق توجهي. وكانت هناك أيضًا جريدة النداء اليومية، غير أن "الأخبار" تحديدًا، بمادتها الثقافية الغنية وبمقالات كبار الأدباء والكتّاب، كانت مرجعًا مهمًا لجيل كامل. فقد كانت جريدة تحمل طابعًا ثقافيًا وطنيًا، وتفتح نافذة على فكر كتّاب مثل رئيف خوري وعمر فاخوري وغيرهما.
حين انتسبتُ إلى الحزب لم أكن أمتلك النضج السياسي الكافي، لكنني أعتبر أنني تعلّمت الكثير داخل هذه "المدرسة". وقد توسّعت في كتابي في الحديث عن تفاصيل المرحلة الأولى: الاجتماعات مع الرفاق، الأنشطة التي بدأنا القيام بها في الحدث، جمع التواقيع احتجاجًا على الغلاء، توزيع المناشير ليلًا تضامنًا مع العمّال المطالبين بزيادة الأجور. كما لعبت حلقات التثقيف الفلسفي دورًا محوريًا، حيث تعرّفت إلى المادية الجدلية والمادية التاريخية، وكانت هذه كلها موارد فكرية ضخمة بالنسبة إلى فتى في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره. وقد أثرت فيّ تأثيرًا كبيرًا، فأنضجت وعيي الثقافي والفكري مبكرًا.

تقول في مقدمة كتابك: "هذه السيرة ليست سيرة رجل منتصر بل سيرة رجل عاش على الحدّ. على حدّ الإيمان بالفكرة وحدّ الخوف على الأبناء وحدّ الغربية بين وطنين. كيف تعيش حالة "الغُربة بين وطنين"، لبنان وكندا؟ هل تشعر أنّك موزّع بين مكانين؟ وبرأيك وهل الغربة تجربة جغرافية فقط، أم هي أيضًا غربة فكرية أو سياسية أو وجدانية؟
الغربة ليست مجرّد ابتعاد عن المكان؛ إنها غربة عن البيئة التي اعتدتَ أن تعيش فيها. فالمكان ليس جغرافيا فحسب، بل هو شبكة علاقات وحياة كاملة. حين جئتُ إلى هنا بشكل نهائي، كنت في الرابعة والستين من عمري. ومنذ أن بلغت الثلاثين حتى تلك السن، كان عالمي كلّه في لبنان: علاقاتي، أصدقائي، أقاربي، والناس الذين يشبهونني في الاهتمامات والرؤية. كل هؤلاء انقطعوا عني فجأة، ووجدت نفسي في مجتمع جديد عليّ أن أعيد بناء شبكة علاقات فيه من الصفر.
غير أن الإنسان، كلما تقدّم في العمر، يصبح أكثر ميلاً إلى الانزواء، وتخفّ طاقته على بناء علاقات جديدة كما كان يفعل في سن الخامسة والعشرين أو الثلاثين. وفوق ذلك، فإن الدينامية الاجتماعية والسياسية في لبنان قوية وحادّة ومليئة بالحركة والنقاش والصراع، بخلاف الوضع هنا في بلد الهجرة، حيث تختلف إيقاعات الحياة الاجتماعية كثيرًا عمّا اعتدناه.
كل هذا يجعلك تشعر فعلًا بأنك في حالة اغتراب، بخلاف من يأتي إلى هذا البلد في سن الخامسة عشرة مثلًا، فينمو وهو يشعر بأن المجتمع الجديد جزء منه. أما أنا، فمع كل محاولاتي للعثور على علاقات جديدة هنا، ما زلت أشعر بالغربة. أشعر –كما قلتُ في الكتاب– بأنني أعيش عند الحافة، على الحدّ بين وطنين.
تشير في كتابك إن الحلّ الطائفي في لبنان لم يكن مجرد تسوية سياسية لإنهاء القتال، بل تحول إلى آلية دائمة لتقاسم الدولة وتمكين زعماء الميليشيات. وتستعيد إحساس والدك عن حتمية هذا الانفجار، هل الطائفية منذ نشوء لبنان أداة مقصودة لإبقاء المجتمع اللبناني منقسماً؟
كان موقف والدي تجاه النظام اللبناني قائمًا على رؤية شاملة لجوانبه الطبقية والسياسية والاقتصادية. فقد كان يعتبر أن هذا النظام، في جوهره الاقتصادي، يمثّل مصالح الرأسماليين، بينما يبقى العمال والطبقات الكادحة مهمَّشين ومَسحوقين في مجتمع يفتقر إلى أبسط مقومات العدالة الاجتماعية. أمّا من الناحية السياسية، فكان يرى أنّ الطائفية تمنح امتيازات لطائفة على حساب أخرى، في تعارض واضح مع أبسط مبادئ المساواة بين البشر. فالمجتمع، في رأيه، لا يمكن أن يستقيم ما لم يكن أفراده متساوين في الحقوق والواجبات، وهذا الحدّ الأدنى لم يكن متوافرًا في لبنان.
وكان والدي يعتقد، على وجه الخصوص، أنّ النظام السياسي –وما كان يُسمّى آنذاك بـ"المارونية السياسية"– يمثّل تيارًا يمينيًا رجعيًا ذا نزعة عنصرية، يمنح نفسه امتيازات على المسلمين تحت قناعة راسخة بأنّ له حقًّا طبيعيًا في ذلك. وكان هذا النظام، في الوقت نفسه، يعبّر عن مصالح التحالف بين الإقطاع ورأس المال.
وإلى جانب هذه الرؤية الاجتماعية والسياسية، كان لوالدي موقف حاسم من سياسة لبنان الخارجية، وخصوصًا في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية وعلاقة الدولة اللبنانية بالغرب. فقد رأى أن انحياز النظام اللبناني التاريخي إلى الغرب –بما يمثله من استعمار وهيمنة– يتناقض مع التوجهات العروبية ومع فكرة الاستقلال الوطني. وكان هذا الإدراك جزءًا من وعي التقدميين واليساريين في لبنان عمومًا، الذين اعتبروا الغرب قوة مضادة للعروبة ولحركات التحرّر.
لذلك كلّه، كان والدي يشعر بأن ما كان يجري في البلاد قبل اندلاع الحرب لا يبشّر بالطمأنينة، وأن التحضيرات والمناخات السائدة آنذاك كانت تشير إلى أن الازدهار الذي يظهر على السطح هو مرحلة عابرة، وأن النظام الطائفي يحمل في داخله بذور الانفجار.
وقد كان هذا الوعي بالطائفية موجودًا بين شرائح واسعة من اللبنانيين، وإن لم يكن عامًا. أما بالنسبة للشيوعيين والتقدميين واليساريين، فكان الموقف ثابتًا وواضحًا: النظام اللبناني نظام مأزوم على المستويين الاجتماعي والوطني. فهو من جهة مرتبط بالغرب وبتأثيراته، ومن جهة أخرى عاجز عن تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي كلا الجانبين، أي في المجالين اللذين يُفترض أن يستمدّ منهما شرعيته الشعبية، كان النظام ساقطًا.
حتى في محيطنا الاجتماعي، كان هناك من يميلون إلى التيار اليميني، وكانوا معادين لكل ما هو عروبي، في حين كانت العروبة في بيتنا جزءًا من الوجدان، وكانت أفكار عبد الناصر وفلسطين عناصر ثابتة في وعينا. وقد ذكرتُ في الكتاب كيف استقبلنا خبر وفاة عبد الناصر؛ إذ شعرت الأسرة وكأن الهواء انقطع من الفضاء، وكأننا اختنقنا حين تلقّينا هذا الخبر.

من محطات حياتك في الكتاب، تتحدث عن عشر سنوات عشتها في موسكو، واعتبرتها محطة أساسية في تكوينك الفكري ورؤيتك للعالم. كيف أثّرت هذه التجربة في وعيك السياسي؟
كانت إقامتي في موسكو فرصة ثمينة بالنسبة إليّ؛ ففي الوقت الذي كان فيه الرفاق الملتزمون في لبنان منخرطين في مهام نضالية قد تُكلّف بعضهم حياتهم في سبيل القضية، كان المناخ المتاح لنا كطلاب في موسكو يتيح نوعًا من التعلم لم يكن متاحًا لرفاقنا هناك. فقد شمل المنهج الدراسي موادّ في الاقتصاد السياسي، والفلسفة، وتاريخ الحزب الشيوعي، والشيوعية العلمية، وكلها شكّلت فرصة للطلاب الراغبين في التعمّق في النظرية، بعيدًا عن حلقات التثقيف السريعة والضيقة التي كانت تُعقد في لبنان.
في موسكو، كان بوسع الطالب أن يقرأ جزءًا كبيرًا من مؤلفات ماركس وإنجلز ولينين، لأن هذه القراءات كانت مطلوبة ضمن البرنامج الأكاديمي الجامعي، ما أتاح لمن يرغب أن يتعمّق فيها بجدية، لا أن يتعامل معها كمجرد مواد دراسية عابرة.
أمّا بالنسبة إليّ، فقد كنت مهتمًا أصلًا بهذه الأسئلة الفلسفية المقلِقة بالنسبة لي، ولهذا ذكرتُ في الكتاب أني، إضافة إلى البرنامج الرسمي، التحقتُ ببرنامج اختياري ودرستُ لسنة كاملة «تاريخ الفلسفة». ولم يكن هذا مقررًا إلزاميًا، بل مساقًا تطوعيًا يسجّل عليه الطلاب إذا رغبوا، وكانت لنا محاضرات أسبوعية تمتد لثلاث ساعات. وقد أسهم هذا المساق في تعزيز الأسس النظرية للماركسية – اللينينية لديّ، وكانت تلك فرصة استفدت منها إلى أقصى حد خلال وجودي في موسكو.
في ضوء الحرب الدائرة اليوم، كيف تفسّر موقف روسيا الذي يبدو براغماتيًا ومترددًا تجاه المقاومة في لبنان وغزة؟ وهل يدفعك هذا السلوك إلى إعادة تقييم دور موسكو كقوة مضادّة للهيمنة في الشرق الأوسط؟
أوّل ما ينبغي قوله هو أنّ روسيا اليوم ليست الاتحاد السوفييتي. فالاتحاد السوفييتي كان يحمل مشروعًا اشتراكيًا واضحًا، وكانت لديه التزامات ثابتة تجاه حركات التحرّر في العالم والدول الصديقة. فقد التزم بدعم البلدان الاشتراكية، ووقف إلى جانب كوبا، وقدّم دعمًا واسعًا لحركات التحرّر في أفريقيا، وساند الثورة الفلسطينية دعمًا غير محدود. كان الاتحاد السوفييتي جزءًا من منظومة عالمية تشكّل سندًا أساسيًا لقوى التحرّر في العالم.
لكن الانقلاب على المشروع الاشتراكي السوفييتي وتفكّك الاتحاد أحدثا تغييرات عميقة داخل روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة، وأعادا إحياء الرأسمالية فيها. وهكذا تحوّلت روسيا إلى دولة رأسمالية، جزء من النظام الرأسمالي العالمي.
وبعد الانهيار، حملت النخب الروسية أوهامًا كبيرة بشأن إمكان اندماج روسيا في السوق الرأسمالية العالمية، وظنّت أن التحوّل إلى الاقتصاد الرأسمالي سيجلب الازدهار للشعب الروسي. لكن تبيّن لاحقًا أنّ هذا التحوّل أنتج استقطابًا طبقيًا حادًّا داخل روسيا، إذ استحوذت أقلية ضئيلة على معظم ثرواتها، فيما سُحقت الأغلبية وعاشت على الهامش.
وإلى جانب ذلك، لم يقبل النظام الإمبريالي العالمي بالرأسمالية الروسية لاعبًا متساويًا داخل نظام تقاسم النفوذ والثروات عالميًا. فالولايات المتحدة وأوروبا الغربية عملتا، منذ البداية، على تفكيك روسيا وإضعافها. إذ أنّ روسيا، في الحقبة السوفييتية، كانت تشكّل عقبة كبرى أمام الهيمنة الإمبريالية. ومع الانقلاب الداخلي والتدخّل الغربي، ظنّت القوى الإمبريالية أنّ اللحظة قد حانت لتفكيك روسيا والسيطرة على ثرواتها.
ومع مرور الوقت، بدأت النخب الرأسمالية والتيارات الوطنية داخل روسيا تدرك أن التحوّل الرأسمالي كان بوابةً نحو تفتيت روسيا وتدميرها كدولة. وهذا الوعي الجديد استنفر التيارات الوطنية، التي وإن كانت جزءًا من منظومة رأسمالية، إلا أنها تملك مصالح ورؤية قومية. وقد التقت هذه المصالح مع الشعور الوطني في محاولة لاستعادة مكانة روسيا وهيبتها في العالم، خصوصًا أنّ روسيا دولة نووية، وتملك أكبر احتياطيات للطاقة والمعادن، وهي قارة قائمة بذاتها ذات تاريخ طويل وحضارة راسخة، يصعب على الغرب ابتلاعها أو إخضاعها، كما حاول –ولا يزال– مع دول أخرى كإيران، التي تستند بدورها إلى إرث حضاري يمنع انهيارها.
ولهذا تسعى روسيا اليوم، مع الصين ودول "البريكس"، إلى بناء تحالف قادر على مواجهة مراكز الإمبريالية العالمية. وبناءً على ذلك، فإن روسيا في سياستها الخارجية الحالية لا تتعامل بالمنطق نفسه الذي كان يحكم الاتحاد السوفييتي، ولا تعود أولوياتها مرتبطة بدعم حركات التحرّر الوطني. إنها دولة رأسمالية تضع مصالحها القومية والاستراتيجية فوق أي اعتبارات أخرى.
هذا يعني أنّ روسيا ليست في موقع القطيعة مع إسرائيل كما كان الاتحاد السوفييتي. فالعلاقات بين موسكو وتل أبيب قائمة اليوم، ولسياسة إسرائيل نفوذ لا يُستهان به داخل روسيا، خصوصًا في وسائل الإعلام، وربما يمتدّ جزء من هذا النفوذ إلى دوائر القرار. وينطلق الكرملين أيضًا من أنّ أكثر من مليون إسرائيلي هم من أصول روسية، ويحملون ثقافة روسية، ما يعزز الروابط بين البلدين.
أما الموقف الروسي من القضية الفلسطينية فهو ثابت من حيث المبدأ: دعم حلّ الدولتين وضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم. لكن هذا الموقف لا يتجاوز حدوده التقليدية، ولا يتحوّل إلى دعم فعلي لحركات المقاومة. فالمقاربات الروسية في المنطقة قائمة على البراغماتية وعلى حسابات المصالح، مع الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية والإمارات وتركيا، واعتبار إيران حليفًا استراتيجيًا.
وفوق ذلك، لدى موسكو أولويات أكثر إلحاحًا، مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وبمحاولات حلف الناتو التمدد في دول الشمال ومحاصرتها من البحر. وهذه قضايا ذات بعد استراتيجي ضاغط يجعل روسيا أقلّ انخراطًا في صراعات الشرق الأوسط.
وبناءً على ذلك، أرى أنّ روسيا ليست الاتحاد السوفييتي، ولا ينبغي أن نحاكم سياستها الخارجية اليوم بمعايير تلك المرحلة. فنحن نعيش في عالم مختلف تمامًا، تحكمه معادلات جديدة.

في دفاعه عن الحزب الشيوعي يقول زياد الرحباني: "لم يترك الحزب إلّا مَن كان يجب أن يتركه، ولم يَطْفُ على سطحه أو يهوِ إلى قعره إلّا مَن كان محكوماً بذلك. هل تغطي عبارة زياد إخفاقات بنيوية في تجربة اليسار اللبناني؟
أعتقد أنّ ما قاله زياد الرحباني يعبّر، في جوهره، عن حالة مرّ بها كثيرون من الذين كانوا صادقين ونقيّين في التزامهم بالمشروع الاشتراكي. فالصادم بالنسبة للكادر الحزبي، وبالنسبة لأشخاص مثل زياد، وربما مثلي أنا وكثيرين غيرنا ممّن كانوا مخلصين لانتمائهم، هو ما حدث على مستوى القيادات الحزبية بعد الانهيار الذي أصاب التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي وتفكّك المنظومة الاشتراكية. فقد شكّل ذلك الزلزال التاريخي لحظة مفصلية دفعت عددًا من القيادات الأساسية في الحزب إلى الانقلاب على تاريخها ومواقفها وميراثها الفكري.
هذا التحوّل أحدث شرخًا كبيرًا في موقع الحزب ودوره، وأضعف علاقته بقواعده. ولذلك فإن كلام زياد لا يعبّر عن موقف فردي، بل يعبّر عن ألم عميق لدى كثيرين من المؤمنين الحقيقيين بالقضية، الذين وجدوا أنفسهم أمام قيادات كانوا يثقون بها ويتّخذونها مرجعًا، فإذا بها تنقلب على المشروع الذي ناضلت ضمنه طوال حياتها، وتتبنّى خيارات ليبرالية وتبحث عن مواقع جديدة خارج الإطار الذي طالما دعت الناس إلى الانخراط فيه.
يرتكز مقال لك في جريدة الأخبار بعنوان "في مواجهة السياسات الإمبريالية" بتاريخ 1-11-2023، على تصورٍ بنيويّ لمعادلة الهيمنة الإمبريالية تقوم على ثلاثي: المراكز الإمبريالية، والكيان الصهيوني، والأنظمة العربية الرجعية. كيف يفسّر هذا التصور البنيوي التحولات الجارية اليوم، خصوصاً في سياق الحرب على غزة والمقاومة في لبنان؟
برأيي، إذا أردنا فهم الموقف الغربي من القضية الفلسطينية، فعلينا العودة إلى الجذور. فالسؤال الأساس هو: لماذا يقف الغرب بأكمله تقريبًا ضد الشعب الفلسطيني؟ ولماذا هذا العداء غير العادي تجاه الفلسطينيين؟ لقد ظهرت هذه المعاداة بوضوح بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، إذ جاءت ردود فعل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وغيرها من الدول الغربية عنيفة ونابذة إلى حدّ لافت، وكأنها تكشف عن موقف عميق ومتجذّر ضد أي تهديد يُتصوَّر أنه موجّه إلى إسرائيل. وهذا يطرح سؤالاً آخر: لماذا هذا الانحياز المطلق، رغم أنّ الفلسطينيين دخلوا في اتفاق أوسلو منذ عقود، ورغم أن المفترض أنّ دولة فلسطينية كانت ستقوم منذ زمن طويل، بينما ما زالت المستوطنات تلتهم الضفة الغربية، حتى باتت الدولة المستقلة القابلة للحياة أمرًا شبه مستحيل؟ كلّ ذلك يجري من دون محاسبة أو مساءلة دولية جدّية.
برأيي، المشروع الصهيوني ليس منفصلاً عن التاريخ الاستعماري للغرب، بل هو امتداد طبيعي له. فالتاريخ الاستعماري الممتدّ نحو خمسة قرون، الذي رافق نشوء الرأسمالية، قام على البحث عن المواد الأولية والأسواق الجديدة، وعلى التوسع والهيمنة. خلال هذه العملية، ارتُكبت جرائم إبادة بحق الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. فالغرب لا “يكتشف” هذه القارّات، كما يزعم، بل احتلّها وأباد سكانها الأصليين. والأرقام حول حجم الإبادة مرعبة.
هذه الإبادات، إضافةً إلى استعباد ملايين الأفارقة ونقلهم إلى “العالم الجديد” للعمل في المزارع والمعامل، هي التي أسّست للتراكم الأولي لرأس المال. أي أنّ الرأسمالية الغربية بُنيت على دماء وجماجم ملايين البشر، وليست مجرد نظام اقتصادي نشأ بطريقة طبيعية أو سلمية. والمشروع الصهيوني هو، في جذوره، جزء من هذا المسار، مرتبط بالبنى السياسية والاقتصادية للغرب وبالولايات المتحدة تحديدًا. ولهذا نجد التطابق شبه التام بينه وبين المصالح الغربية.
أما البلدان العربية، فقد وقعت تحت الاستعمار بعد سقوط الدولة العثمانية وجرى تقسيمها وفق اتفاقية سايكس ـ بيكو. وخلال فترة الاستعمار، نشأت في هذه البلدان بنى اقتصادية وسياسية واجتماعية صُمِّمت لاستدامة تبعيتها للمراكز الإمبريالية. وهذه التبعية الخارجية لها أدواتها الداخلية: نُظم سياسية تحافظ على مصالح شرائح اجتماعية مترابطة مع السوق المالية العالمية والشركات العابرة للحدود، وبالتالي لا مصلحة لها في تحرير فلسطين ولا في تبنّي مشروع وطني مستقل. وما نسمّيه “خيانة” ليس، بالنسبة لهذه الأنظمة، خيانة؛ بل هو امتداد طبيعي لوظيفتها ودورها الذي أنشأه الاستعمار ورعاه.
لذلك يصبح “طبيعيًا”، في هذا الإطار، أن نرى مواقف مثل مواقف الإمارات أو السعودية أو مصر أو الأردن أو المغرب؛ فهذه الأنظمة تعبّر عن مصالح طبقات مرتبطة بنيويًا بالنظام العالمي، لا بمصالح شعوبها. والمشروع الصهيوني، بالنسبة إليها، شرط من شروط بقائها واستمرارها في السلطة.

يرفض مقالك اختزال المقاومة الفلسطينية في بعدها الديني أو الأيديولوجي، ويقدّمها بوصفها فعلاً مادياً يساهم في تعطيل وظيفة الهيمنة الإمبريالية. هل تستطيع المقاومة أن تؤسس تحوّلاً بنيوياً في النظام العالمي، أم أن دورها يبقى مرتبطاً بردّ فعل على السياسات الإمبريالية دون قدرة على بناء مشروع بديل شامل؟
ما أقصده بالبعد الديني للصراع: أي محاولة تغطية جوهره أو تشويهه عبر إضفاء طابع ديني عليه، رغم أنّ هناك بالفعل قوى تقاتل بدوافع دينية. لكن مضمون الصراع في جوهره تحرري ووطني. فهناك مشروع استعماري يسعى إلى طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، وإلى فرض الهيمنة على شعوب المنطقة والتسيّد عليها. صحيح أنّ هذا المشروع يستخدم في أيديولوجيته روايات دينية وأساطير توراتية، لكن مضمونه الفعلي هو مضمون استعماري إحلالي، مرتبط بمصالح مراكز الرأسمال المالي العالمي والمصارف والشركات العابرة للجنسيات. هناك اندماج كامل بين هذا المشروع الاستعماري ومصالح القوى الإمبريالية.
لهذا أقول إنّه لا ينبغي لنا أن نُعطي الصراع طابعًا دينيًا؛ فالقضية الفلسطينية ليست صراعًا دينيًا، بل قضية تحرّر وطني. والمشكلة الأكبر التي يواجهها الشعب الفلسطيني اليوم هي غياب قيادة وطنية موحّدة تمتلك مرجعية واضحة للنضال. هذا الانقسام داخل الحركة الوطنية الفلسطينية كلّف الفلسطينيين –ولا يزال يكلّفهم– الكثير.
الأولوية بالنسبة للشعب الفلسطيني يجب أن تكون تشكيل قيادة وطنية موحدة، على أساس الحدّ الأدنى من التفاهمات الوطنية، لا على أسس اتفاق أوسلو. وقد جرت محاولات عديدة لتحقيق هذا الهدف، لكنّها فشلت، لأن جزءًا من القيادة الفلسطينية، وخصوصًا السلطة، أصبح مرتبطًا بمصالح مختلفة، بل إنّ شريحة داخل السلطة باتت مصالحها وارتباطاتها تتقاطع مع الاحتلال نفسه. وهذا ما خلق حالة استعصاء سياسي وتنظيمي.
هذه الحالة ستُكلّف الشعب الفلسطيني المزيد من التضحيات والدماء، إلى أن تنضج ظروف تؤدي إلى ولادة قيادة وطنية فلسطينية جديدة. وعندها فقط يمكن الحديث عن بداية أمل حقيقي بأن يحقق النضال الوطني الفلسطيني أهدافه.
في مقال لك "مسبار وأوهام العظمة" في جريدة الأخبار بتاريخ 19-2-2021 تتحدث أنّ مشروع "مسبار الأمل" ليس مجرد تعاون علمي عابر، بل هو جزء من منظومة سياسية–اقتصادية تُعيد إنتاج هيمنة الولايات المتحدة عبر خلق رموز حداثية مُعَلَّبة لحلفائها في المنطقة. هل ترى أن هذه المشاريع جزء من إعادة تشكيل المنطقة بما يتناسب مع تحالفات عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
كتبتُ تلك المقالة كردّ فعل على محاولة تقديم الحدث وكأنه إنجاز تاريخي كبير، في إطار عملية ترويج واسعة للإمارات، تُعرض من خلالها كأنّها نموذج حداثي تتيحه “مكافأة التطبيع”، وأنّ من يطبّع يصبح على هذه الصورة. وهذا التقديم يُخفي جملة من الحقائق الجوهرية.
أولًا، حتى لو وُجدت مظاهر حداثية في الإمارات، فإن هذه المظاهر والمشاريع قامت على أكتاف ملايين العمّال الذين جرى استغلالهم بشكل وحشي في القرن العشرين والواحد والعشرين، وخصوصًا العمالة الآسيوية. فالرأسمالية، عندما فتحت الأسواق وحطّمت الحدود أمام حركة رأس المال، حطّمت أيضًا الحدود أمام اليد العاملة، لكن بشروط قاسية ولا إنسانية. وحين ننظر إلى الإمارات، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين عامل أجنبي في ظروف أشبه بالوحشية، نفهم ما الذي يقف خلف هذه الواجهة البراقة: طبقات هائلة من الظلم والاستغلال.
ثانيًا، الدور الذي تلعبه الإمارات اليوم هو وظيفة سياسية واقتصادية مرتبطة بقرار أميركي. فبعد أن جرى إنهاء الدور التاريخي لبيروت كمركز مالي وساحة ترانزيت إقليمية، اتُّخذ قرار بنقل هذا الدور إلى الإمارات. ومع هذا التحوّل، أصبحت العائلات الحاكمة هناك أدوات تنفيذ في عمليات ضخمة تتعلّق بتبييض الأموال، والنهب، والتحويلات المالية العابرة للحدود، في بيئة تُشبه الملاذات الضريبية كالجزر العذراء، حيث الحرية المطلقة لحركة رؤوس الأموال والتجارة. وهذا هو الأساس الفعلي للـ“ازدهار” في دبي والإمارات عمومًا.
وبرأيي، يكفي أن نقول إنه بقرار واحد يُتَّخذ في ليلة بلا قمر في واشنطن، يمكن أن ينهار كل هذا البناء خلال 24 ساعة. وهذا ما يجعل هذا النموذج هشًّا، متعلقًا بالخارج أكثر مما هو نابع من قدرات ذاتية.
وعندما كتبتُ عن “المسبار”، تناولتُ الموضوع علميًا، كباحث وأستاذ جامعي في المجال الهندسي، وشرحتُ الشروط العلمية والتقنية التي تتيح لدولة ما أن تصبح عضوًا في “نادي الدول الفضائية”، القادرة على إطلاق مركبات إلى الفضاء العميق. والواقع أنّ ما حدث لم يكن نتاج مشروع علمي إماراتي مستقل، بل نتيجة تمويل، وشراء خدمات، وتلميع إعلامي. ويمكن مقارنة ذلك مثلًا بإيران، التي رغم الحصار والضغوط، أطلقت قمرًا صناعيًا بجهودها الذاتية، وهو ما يوضح الفارق بين مشروع دعائي وآخر مبني على قاعدة علمية فعلية.
وما دفعني إلى كتابة المقال أيضًا هو أنّ بعض الأشخاص الذين يعدّون أنفسهم من اليسار انبهروا بهذه الصورة المروَّجة، وقارنوا بين الإمارات ودبي وبين مشاريع تنموية حقيقية. لكن هذه ليست حداثة. الحداثة الحقيقية تبدأ بمشروع تنموي مستقل، وببناء اقتصاد منتج، لا اقتصاد قائم على الخدمات والريعية.
يكشف الكاتب الكندي إيف إنغلر في كتبه عن تورط كندا من هاييتي، إلى روسيا وأوكرانيا، إلى ليبيا، وأفريقيا، إلى إسرائيل، كيف ترى العلاقة الأميركية ــ الكندية ودفع كندا للاندماج داخل "نادي المركز الإمبريالي"؟
برأيي، فإن النظام السياسي في كندا وموقعها في تقسيم العمل الرأسمالي العالمي يجعلان منها جزءًا من المنظومة الاقتصادية والسياسية الدولية. صحيح أنّ كندا لا تُسلَّط عليها الأضواء دائمًا عند الحديث عن السياسات الخارجية، لكن عمليًا هي منخرطة في هذا الدور ومحمية ضمن المظلّة الأميركية. والدليل على ذلك مشاركتها في العمليات العسكرية في أفغانستان، وفي العراق ولو بأشكال مختلفة.
كما أنّ الشركات الكندية المنتجة للأسلحة تعمل بتنسيق كامل مع الشركات الأميركية. ومن هنا، فإن دعم كندا لإسرائيل والاندماج التام في الموقف الأميركي ليسا أمرًا مخفيًا؛ بل هما معلنان وصريحان.
صحيح أنّ بعض الشخصيات السياسية، من نواب أو وزراء، تحاول أحيانًا القيام بأنشطة ذات طابع اجتماعي مع الجاليات العربية أو المسلمة، من باب العلاقات العامة، لكن هذا هو سقف الدور. أما في السياسة الخارجية، سواء لدى الحزب الليبرالي أو المحافظين، فإن الخطّ واحد: التعبير عن مصالح الرأسمال الكندي المندمج في النظام الرأسمالي العالمي، خصوصًا في ظل قرب كندا الجغرافي والسياسي من الولايات المتحدة.
ورغم الإهانات السياسية التي صدرت أحيانًا من الإدارة الأميركية، خصوصًا في عهد ترامب، بقيت كندا ضمن المسار نفسه وتقبّلت ذلك دون ردود فعل تُذكر، لأنها لا ترى مشكلة في النظام الرأسمالي العالمي، بل تعتبر المشكلة في الأشخاص وليس في البنية.
وموقف كندا من الحرب في أوكرانيا مثال واضح؛ فهي متشدّدة كأميركا تمامًا في إرسال السلاح والدعم العسكري. ولو أنّ جزءًا من هذه الموازنات العسكرية صُرف على التعليم أو الصحة، لكان وضع الناس في كندا أفضل بكثير. لكن هناك عملية مستمرة لتشويه الوعي وتضليل الرأي العام، عبر تصوير الصين وروسيا كـ“بعبع” وعدوّ دائم، والعمل على تغذية هذا الخطاب بشكل مستمر.
وبهذا تُغطّى الحاجات الاجتماعية الفعلية للناس عبر خطاب التخويف، وإقناعهم بأن على كندا أن تزيد التسلّح وأن تبقى متحالفة بالكامل مع الولايات المتحدة، وإلا فإن أمنها سيكون مهدَّدًا.

تعتبر أن القوى اللبنانية المعادية للمقاومة ليست مجرد أطراف طائفية متباينة، بل تشكّل امتداداً لبنية الغرب الإمبريالي.كيف يمكن تفسير هذا الارتباط البنيوي؟ هل هو مجرد "تحالف مصالح"، أم تعبير عن موقع لبنان كدولة طرفية داخل نظام عالمي تهيمن عليه الولايات المتحدة؟
أول ما يجب قوله هو أنّ القوى السياسية تعبّر دائمًا عن مصالح شرائح اجتماعية محدّدة. فإذا أردنا أن نسأل: من يحكم لبنان فعليًا؟ برأيي، الذين يحكمون لبنان هم المصارف، وكبار التجار، وأصحاب الشركات التي تمتلك الامتيازات. هذه القوى الاقتصادية هي الحاكمة الحقيقية للبلاد، فيما يأتي النواب ليعبّروا عن مصالحها، ويعمل النظام الطائفي والقوى الطائفية كأدوات سياسية لها.
فالقوى الطائفية في لبنان تعبّر، في جوهرها، عن مصالح الطبقة الاقتصادية المهيمنة، وهي برجوازية كومبرادورية، أي برجوازية مرتبطة بالأنشطة الريعية والمالية والتجارية، لا بالاقتصاد المنتج. ولهذا رأينا كيف نهبت المصارف أموال الناس، وكيف حصل تواطؤ بينها وبين النظام المالي العالمي، وصولًا إلى حصار لبنان، وتطبيق “قانون قيصر” على سوريا وما رافقه من تداعيات. وحتى اليوم لم يُتخذ أي إجراء جدي لإعادة أموال المودعين المنهوبة.
واللافت أنّ كل القوى الطائفية والسياسية، مهما اختلفت هويتها الطائفية أو خطاباتها الإعلامية، متفقة في هذه المسألة. وهذا يطرح سؤالًا بديهيًا: لماذا تتفق كل هذه القوى المتصارعة على السلطة –والتي لا تتوقف عن شتم بعضها والتحريض المتبادل إعلاميًا– حين يتعلق الأمر بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية؟ والسبب هو أنّها جميعًا جزء من البنية نفسها التي تحمي مصالح القوى الاقتصادية الحاكمة.
مع ذلك، يبقى هناك تمايز واحد أساسي بين القوى السياسية، وهو الموقف من إسرائيل. فمن الواضح أنّ “الثنائي الشيعي”، ولا سيما حزب الله بدرجة أكبر من حركة أمل، يقف في موقع المواجهة مع المشروع الصهيوني ويقدّم شهداء في هذا المسار. ولذلك، على المستوى الوطني، هناك انقسام كبير لا يمكن إنكاره. وهذا الانقسام يفسّر لماذا لا يمكن وضع القوات اللبنانية وحزب الله، مثلًا، في الخندق نفسه، رغم توافق الكثير من القوى الداخلية في المسائل الاقتصادية.
في ضوء الانخراط المباشر للمقاومة في لبنان في إسناد غزة منذ اليوم التالي لطوفان الأقصى، وما تكبّدته من خسائر بشرية وميدانية، كيف تنظر إلى الوظيفة الاستراتيجية لهذا التدخل. هل تعتبر هذا الإسناد خطأ؟ وكيف تقرأ الدعوات الداخلية التي تتجدد بعد كل مواجهة للمطالبة بـ تسليم السلاح أو حصره بالدولة؟
أنا لا أرى أنّ الخطأ كان في أنّ حزب الله أسند غزّة، بل على العكس تمامًا؛ الخطأ أن الآخرين لم يُسندوا غزّة. فالمسألة تُطرَح اليوم بطريقة معكوسة: بدل أن يُسأل الآخرون ــ وأقصد الأنظمة التي وصفتُ طبيعتها سابقًا ــ عن سبب تخليها عن الشعب الفلسطيني، يُوجَّه اللوم إلى من قام بالحدّ الأدنى من واجبه.
هذه الأنظمة، بما تملكه من إمكانات هائلة وجيوش ضخمة وتنفق مئات مليارات الدولارات على التسلّح، هي التي يُفترَض أن تكون في مقدّمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولدفاع الشعب الفلسطيني عن حقّه. لكنّ ما يحصل هو أنّ من يقوم بواجبه يُدان، بينما يُسكت عن المتواطئين والمتآمرين. لذلك يجب أن يكون السؤال الحقيقي: لماذا تواطأ الآخرون ولم يدعموا الشعب الفلسطيني؟ وليس: لماذا دعم حزب الله غزّة؟
أما بالنسبة إلى الدعوات المطالِبة بحصر السلاح بيد الدولة، فهي تُقدَّم اليوم باعتبارها رؤية مختلفة للأمن الوطني، وأنها يجب أن تتحقق. لكن هذه الدعوات تأتي في سياق الاختلال الكبير في موازين القوى الذي نتج عن المواجهة الواسعة التي خاضتها المقاومة في لبنان. وبرأيي، لم تكن المواجهة مع إسرائيل وحدها، بل مع تحالف الناتو بأكمله؛ فكل دول الناتو شاركت في العدوان على لبنان، ومعها الصهاينة والأميركيون وبعض القوى العربية الرجعية. هذا التحالف هو نفسه الذي يقاتل في فلسطين ولبنان واليمن وإيران والعراق وغيرها.
أمام تحالف يضمّ أقوى دول العالم، كان من الطبيعي أن يحدث خلل كبير في موازين القوى، وأن يحقق هذا التحالف تفوقًا في بعض المواقع. وبفعل هذا الخلل، برزت قوى داخلية في لبنان مرتبطة بالمشروع الأميركي ـ الصهيوني. وأنا أستخدم مصطلح "الصهيوني" هنا بمعناه الواسع: كل من يدعم مشروع الهيمنة الإمبريالية على المنطقة هو، برأيي، جزء من المشروع الصهيوني، حتى لو لم يُعلن دعمه لإسرائيل مباشرة.
ولاحظي كيف تطوّر الخطاب الداخلي: بدأ بالمطالبة بـ"الحياد"، ثم تحوّل إلى مواقف تقول صراحة "نحن مع إسرائيل". كيف يمكن الحديث عن حياد بينما المشروع الصهيوني يقف على حدود لبنان ويعلن سعيه لإقامة "إسرائيل الكبرى"؟ هذه الدبلوماسية ليست سوى تضليل كبير.
برأيي، في لبنان اليوم قوى معادية للمقاومة تعمل كقوى مرتزقة، وهي جزء من تحالف إقليمي ودولي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والمقاومة. لكنني أعتقد أنهم لن ينجحوا، طالما بقيت قوى المقاومة ترفض الاستسلام وترفض رفع الراية البيضاء.
في عام 1982 وصلت إسرائيل إلى بيروت، لكن المقاومة طردت الجيش الإسرائيلي لاحقًا وحرّرت لبنان، وألحقت الهزيمة بإسرائيل وبحلفائها في الداخل. واليوم، رغم الخلل الاستراتيجي الناتج عن إسقاط الدولة السورية وإخراجها من المعادلة، لا يمكن لشعبنا أن يُهزم طالما أنّ هناك قوى تقاوم وترفض الخضوع. المعركة طويلة، لكنها لن تنتهي بانتصار أعداء المقاومة أو بفرض المشروع الصهيوني هيمنته على بلادنا.

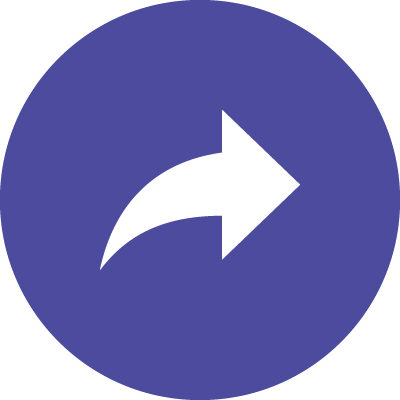




110 مشاهدة
10 مارس, 2026
313 مشاهدة
16 فبراير, 2026
340 مشاهدة
06 فبراير, 2026