دارين حوماني - مونتريال
اختتمت مدرسة أجيال للّغة العربية في المجمّع الإسلامي في مونتريال عامها الدراسي يوم السبت 17 أيار/ مايو 2025 في حفل حاشد، في قاعة المجّمع الرئيسية، تحت شعار "نحتفل بما أنجزناه ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا"، تخللته فقرات فنية وعروض مسرحية قصيرة، وكلمات بالمناسبة لمديرة المدرسة الأستاذة ليلى فرحات، والأستاذ حيان عاصي، وامام المجمع الاسلامي سماحة الشيخ علي سبيتي، وكان ختام الحفل مع تخرّج طلاب الصف التمهيدي إلى المرحلة الابتدائية.
انطلق الحفل مع قراءة آيات من القرآن الكريم، وتتالت الفقرات المسرحية والفنية والتثقيفية وتنوعت بين تمثيل وغناء وأناشيد جميلة، أداها الأطفال بحماس وفرح، وكل صف أطلّ بلباس مختلف أضفى على الحفل روحًا مبهجة وذكرى لا تُنسى، وشكّلت لوحات بصرية مؤثرة في معانيها عكست براءة الطفولة وعمق الانتماء ولامست وجدان الحضور.
ومن الفقرات التي قدّمت، عرض "ما هو الوطن"، عبّر فيه الطلاب عن معنى الوطن بالنسبة لهم، تسأل إحدى الطالبات رفاقها في الصف عن ماهية الوطن، ومن ردود الطلاب: "الوطن مثل البيّ.. الوطن متل شجر الزيتون.. الوطن جار وخيّ، الوطن إم وبيّ.. الوطن أغلى من الروح الوطن بلسم الجروح.. الوطن سهل وجبال، الوطن سواعد ورجال، الوطن مجد وكرامة، الوطن عز وجمال.. لبنان جنة العيش الهني، لبنان أحلى وطن بالدني..".
وقدّم الطلاب مسرحية "الأمل" التي تتناول قضية تدمير البيوت على يد الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة، والمشاعر المصاحبة لهذه الخسارة، ومن ردود الطلاب: "أنا زعلانة على العالم بلبنان عم جرّب أعمل شو ما كان لساعدن... عم وزع أكل للنازحين، عشان ما عندن شي ياكلوه... بعتوني أهلي جيب مي، رجعت لقيت البيوت مدمرة، وما لقيت أهلي... كنا عم نلعب الغميضة ولما رجعت ما لقيتن..".
*
كما قدّم طلاب الصف الثاني أساسي مسرحية "الحيوانات في القرآن". تتحدث المسرحية عن ملك يريد أن يختار وزيرًا قويًا من حيوانات الغابة، ويتوجه كل حيوان له ليعرض عليه قدراته واستحقاقه لتولي هذه المسؤولية، ولكن الأسد لا يرغب باختيار حيوان من "أقربائه" قائلًا "هذا تكليف وليس تشريفًا". مسرحية هادفة تستعيد قصص الحيوانات الي ذُكرت في القرآن بطريقة ذكية محببة للأطفال، فهذا الكلب الذي بقي يحرس المؤمنين في الكهف 309 سنوات، والذئب الذي ادّعى إخوة النبي يوسف أمام والدهم أنه أكل أخاهم يوسف، ثم قصص البقرة الصفراء والفيل والهدهد وغيرهم من الحيوانات. بالنهاية لا يختار الأسد أحدًا، يقول "لا أحد يستحق، كلكم حكيتوا عن أمجاد سابقة ما إلكن علاقة فيها". ثم تحدث عن قصته كأسد في القرآن، وأضاف "أنا زعلان لأن ما حدا منكم قال: أنا تعلمت أنا اجتهدت أنا عملت.. هذا العالم ما فيه مطرح إلا لـ يللي بيتعلم وبيبتكر وبينجز. بس لاقي حدا هيك رح اختاره وزير".

كما أدّت مجموعات من الطلاب من مختلف الصفوف مجموعة من الأناشيد والأغاني الوطنية والإنسانية في لوحات فنية مميزة على خشبة المسرح، منها "موطني، "خليك عربي" مهداة إلى أطفال لبنان وفلسطين، وأغنية "بعيدك يا ماما"، "طير وعلّي يا حمام"، "أنا أجمل تلميذ شاطر"، "حب الله حب المهدي"، و"شو حلوة هل الشمسية".
وكان ختام الحفل مع تخرّج طلاب الصف التمهيدي إلى المرحلة الابتدائية، قدّم لهم الشيخ علي سبيتي شهادات وهدايا تكريمية.

كلمة مديرة المدرسة ليلى فرحات
ألقت مديرة مدرسة الأجيال ليلى فرحات كلمة اعتبرت فيها أن هذا الحفل هو لحظة مشرقة لحصد ثمار الجهود والاحتفاء بالطلاب والمعلمات. واعتبرت أن مدرسة أجيال أصبحت صرحًا يضج بالعلم والإيمان، والذي من أجل هذه القيم تم تأسيسها. وأكدت على أهمية التعاون بين الأهل كجهة واعية والمدرسة التي تقوم بواجباتها التعليمية والتربوية.
وألقت فرحات الضوء على ما مرّ خلال العام الدراسي من أحداث مأساوية منها، حيث التحديات الكبيرة والتضحيات الكثيرة، وفقدان الكثيرين لأعزّاء عليهم، أو لبيوتهم وبيوت أهاليهم وأجدادهم، ودمار الكثير من القرى. وشدّدت على أننا "في ثقافتنا ومعتقداتنا التي ورثناها من ديننا، علينا أن نقوي معنوياتنا وأن نشحذ الهمم"، معتبرة أن المدرسة أكملت رغم كل تلك الظروف بنفس الأسلوب التعليمي والتربوي، وأضافت "ألقينا الضوء على ما مر به أهلنا في لبنان خلال الحرب، وبثّنا روح التضامن والتعاطف، وشرحنا ما حصل لكل صف حسب مستواه، كل هذا لشعورنا بالمسؤولية ودورنا التربوي".
وأثنت فرحات على تواصل الأهل مع المدرسة في كل تفصيل يرتبط بأولادهم وبالمدرسة، عن الحضور لاجتماع الأهالي والمتابعة مع المعلمات، أو بيع منتج ضمن لائحة المقاطعة، أو الطلب من المدرسة تعليم الابن أو الابنة الصلاة أو الحجاب، أو حتى الاعتراض على مفهوم معين في المدرسة وغير ذلك.
واعتبرت فرحات أن هذا يعبّر عن دورة تفاعلية بين الأهل والمدرسة تدل على وعي الأهل، وأضافت "هذه الدورة التفاعلية صنعت بدورها قواعد المدرسة المبنية على التعاون والمشاركة، وبالتالي هدفها وتطويرها هو تقديم ما ينفع. التفاصيل الصغيرة هي التي تجعل منكم عائلة متماسكة وناجحة، وتجعل منا كمدرسة متابِعة في تقديم ما هو أفضل، ومتابَعة من الأهل أيضًا. أي أنه من الضروري أن نتابع هذه المسائل، ولا نقول إن هذا تفصيل صغير ولا أريد أن أتابعه. كل شيء له أثر على نجاح العملية التدريسية، وبالتالي فلنكمل سويًا هذه الطريقة".

كلمة أهالي الطلاب الأستاذ حيان عاصي
عبّر الوالد حيان عاصي عن تقديره لوجود مدرسة أجيال، وقال بأن هذه المدرسة "كانت ولا تزال حصنًا يحافظ على أبنائنا من فقدان هويتهم الثقافية واللغوية والدينية. إنها ليست مجرد مدرسة، بل جسر يصلهم بجذورهم وينمّي فيهم الاعتزاز بثقافتهم العربية الأصيلة".
وشارك تجربته الخاصة، فقال: "وُلدت في مونتريال في وقت لم تكن فيه مدارس تُعنى بتعليم اللغة العربية على هذا المستوى الرفيع، مما جعلني أواجه صعوبات كثيرة عند عودتي إلى لبنان في سن السادسة عشرة، حيث اضطررت للدراسة في مدرسة تعفي من مادة اللغة العربية. واليوم أرى في مدرسة أجيال ما كنت أفتقده، فأشعر بامتنان عميق للجهود المخلصة التي تُبذل للحفاظ على لغتنا الأم وإيصالها إلى أبنائنا بالشكل الأفضل".
وشكر عاصي المعلمات والمدرسة على الجهود التي تبذلنها في سبيل تعليم أبنائنا وغرس القيم والثقافة العربية في نفوس الطلاب.

كلمة الشيخ علي سبيتي
رأى الشيخ علي سبيتي أن "الجهود المبذولة في مدرسة أجيال هي الكفيلة بأن ترفع عنا عذاب الضمير أننا أتينا بأولادنا إلى هذه البلاد، وعلينا أن نعمل على ربطهم بدينهم وتراثهم وتاريخهم"، معتبرًا أن نظام الهجرة أُنشئ ليعمل على اندماج كامل للأجيال التي ترعرعت في هذا المجتمع، وأنهم لا يهمهم لا يهمهم من أي مكان يأتي الناس، من كل الأديان وكل الثقافات، لأنهم يعرفون أن نظام الدمج الموجود بالمدارس وبالمحيط، كفيل بأن يحقق هذا الدمج للجيل الجديد.
وأضاف: "مع الوقت سنصل إلى جيل لا يعرف أصوله الثقافية ويصير ابن البلد، خاصة أن ليس كل الناس قادرين على العيش في البلد الأم. اليوم الظروف تصعب أكثر، وبالتالي لم يكن هناك من حل إلا باللجوء إلى مدرسة للّغة العربية في نهاية الأسبوع، لأن القليل خير من الحرمان".
وأشار الشيخ سبيتي أنه منذ وصوله إلى كندا في أواخر الثمانينيات، بدأ وآخرون بتنظيم حصص لتعليم العربية أيام العطل "لإدراكنا المبكر بخطر الانقطاع عن الأصول"، معتبرًت أنه يكمن هنا الدور الأساسي للأهل، فهم الحلقة الأهم في الحفاظ على اللغة داخل البيت. فالطفل الذي لا يسمع العربية في منزله سيجد صعوبة في فهم جدوى تعلّمها، بل سيربطها بحرمانه من عطلة نهاية الأسبوع. ولكن إذا كان في هذه اللغة حنان الأم وعطاؤها، ولغة خطاب الأب لأبنائه فستصبح محببة له.
الشيخ علي سبيتي أشار إلى أهمية مخاطبة الأبناء بالعربية، مستشهدًا بقصص لأسر أهملت ذلك، ما أدى إلى فقدان الانتماء الثقافي والديني لدى الأبناء، وانخراطهم في بيئات بعيدة عن جذورهم. ولم تبق المشكلة، بعد سنوات، في محيط اللغة والتواصل، بل أصبحت مشكلة شخصية، فالقضية تتجاوز اللغة إلى منظومة القيم المرتبطة بها.
واعتبر الشيخ أن من يزرع الريح يحصد العاصفة، مؤكدًا على أن معظم الجهد الذي يضعه الأهل حاليًا سيحصدونه لاحقًا، وسيتعلم الولد قيمًا انزرعت من خلال اللغة، مؤكدًا على أننا "نحن المسؤولون عن خسارة هذه الثقافة وهذه اللغة، عندما نشعر أننا غير مميزين في المجتمع إلا إذا تحدثنا لغة أجنبية، وهذه مشكلة مجتمعاتنا. الآن عائلات سعيدة لأنها تضع أولادها في مدارس عربية، وهناك في لبنان عائلات سعيدة أن أولادهم يتكلمون لغة أجنبية وليس اللغة العربية، هذا هو الغزو الثقافي".
وأثنى على الأهالي الذين يأتون من مسافات بعيدة لوضع أولادهم في مدرسة أجيال، وأولئك الذين يعيشون على مسافة بعيدة ويعملون جاهدين لتعليم أولادهم اللغة العربية عبر دروس أونلاين ليحافظوا على لغتهم. وكذلك أثنى على المعلمات اللواتي يطوّرن مهاراتهن ليصبح تعليم اللغة العربية ليست لغة تلقينية فقط، بل يدخل فيها الفن، والنثر الشعري، والآية القرآنية، والرواية، بحيث يلتقط التلميذ اللغة من أنشطة متعددة وليس بالتلقين فقط، وهو ما يسمى التعليم بالمهارات.
واعتبر أن وجود الطلاب حضوريًا لها بعد اجتماعي، "إذ يخرج الطفل من العزلة في البيت ويبتعد عن مسألة استخدام الآيباد والتلفون، ويأتي ليعمل اندماجًا مع رفاق يشبهونه من أشخاص يشاركونه العادات والتقاليد، وبالتالي يعتاد على بيئة معينة".
****

الحوار مع مديرة مدرسة الأجيال ليلى فرحات
في عالم تزداد فيه الهجرة وتتداخل الثقافات، تبرز أهمية المحافظة على اللغة الأم والهوية الثقافية كعامل أساسي في بناء شخصية الفرد ومجتمعه. في حوار خاص مع مديرة "مدرسة أجيال" السيدة ليلى فرحات، تكشف لنا عن رؤية تربوية تتجاوز مجرد تعليم اللغة العربية، لتؤكد أن المدرسة هي منبر لتنشئة أجيال تفتخر بأصولها وترتبط بتاريخها وهويتها.
توضح فرحات أن هدف المدرسة لا يقتصر على تعليم اللغة فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز الانتماء والوعي الثقافي والديني لدى الطلاب، حتى يصبحوا أفرادًا قادرين على الاندماج في المجتمع الكندي مع الحفاظ على تراثهم. في هذا الحوار، نسلط الضوء على أهداف مدرسة أجيال وإنجازاتها، وكيف نجحت المدرسة في خلق بيئة تعليمية تفاعلية تحفّز الفضول لدى الطلاب وتُشعرهم بالانتماء لأوطانهم وتراثهم ودينهم.
نود أن نتعرّف على بداية تأسيس مدرسة أجيال لتعليم اللغة العربية، ومنذ متى تتولين إدارتها؟
افتتحنا مدرسة أجيال منذ افتتاحها عام 2002 وهو العام الذي تم فيه شراء مبنى المجمّع الإسلامي. قبل العام 2002، كنا نستأجر مبنى إحدى المدارس كل يوم سبت. استمر ذلك لمدة عامين، حتى شراء المجمّع، وكانت المدرسة أول مشروع تربوي تعليمي في المجمّع.
قدّمتم اليوم عروضًا مسرحية وفنية مميزة، ما الذي تطور هذه السنة في الحفل الختامي عن السنوات الماضية؟
هذا العام، ألزمنا كل صف بأن يُقدِّم فقرة ذات مغزى. لم يكن الهدف أن نقدّم فقرات عشوائية، بل أن نوصل رسائل هادفة. هذا كان غايتنا الأساسية. فقد وجهنا، من خلال بعض الفقرات، رسائل إلى أهلنا في الوطن، كما حرصنا على إبراز الجانب الجمالي والفني لدى الأطفال، بحيث يشعرون بالفرح أثناء تقديمهم للنشيد.
فعلى سبيل المثال، نُعنى دومًا بربط صورة الأم بصورة الوطن، ونُدرج في فقراتنا مواضيع دينية، لأن هذا الجانب يلقى اهتمامًا كبيرًا لدى الأهالي، فهم يحبون أن يروا ما تعلّمه أبناؤهم في هذا المجال. نحن نحاول من خلال هذه الفقرات – مثل فقرة عن الإمام المهدي، أو عرض مسرحي، أو تلاوة آيات قرآنية تتعلق بالحيوانات، وهي فقرة قدمناها للمرة الأولى وكانت مميزة – أن نتناول موضوعات مرتبطة بلغتنا وتراثنا. فنحن نُولي مسألة التراث اهتمامًا خاصًا.
وقد يقول البعض: "ما الذي يعرفه هؤلاء الأطفال عن الوطن الأم؟"، فنجيب: إن لدينا ارتباطًا حقيقيًا به، ونحرص على أن يبقى هذا الارتباط حيًا لدى الأطفال. فنحن نؤمن أن الإنسان لا تكتمل شخصيته إلا إذا كان مرتبطًا بماضيه، عندما يكون له ماضٍ تكون شخصيته رصينة، وهذا ما نؤكد عليه دائمًا.
هل ترين اهتمامًا متزايدًا أو تراجعًا من الأهالي لتعليم أبنائهم العربية؟
نحن أسسنا المدرسة قبل أكثر من عشرين عامًا. ويمكنك أن تتخيلي أن الأطفال الذين التحقوا بها في بداياتها، أصبحوا اليوم آباءً وأمهات، وهم يرسلون أبناءهم إلى المدرسة نفسها. وهذا يدل على أن رسالتنا وصلت، وأننا حققنا الهدف الذي وضعناه منذ البداية.
هؤلاء الذين كانوا تلاميذنا في السابق، والذين ربما كانوا يأتون أحيانًا إلى المدرسة على غير رغبتهم، أصبحوا اليوم أكثر اهتمامًا من آبائهم وأمهاتهم، وكأنهم يحاولون التعويض عمّا فاتهم، وربما يشعرون بشيء من الأسف لأنهم لم يولوا هذا الجانب الاهتمام الكافي في صغرهم. ولهذا نراهم اليوم يتابعون تعليم أولادهم باهتمام بالغ.
وأقول لك بثقة: إذا استمررنا بهذا النهج، فإن مستقبلنا سيكون مشرقًا.
وأضيف أيضًا أن في مونتريال، مدارس عربية أخرى، لأن هناك وعيًا متزايدًا بضرورة القيام بالدور الذي نؤديه نحن. وما يميز شبابنا وفتياتنا اليوم هو قدرتهم على التحدث باللغة العربية وعلى استخدامها بشكل جيد. وربما لمستِ هذا بنفسك من خلال العروض المسرحية والفقرات التي يُقدمها الطلاب، حيث بات هناك نوع من الطلاقة والمرونة في الأداء.
ولعل اللافت أن المدرسة هي فقط ليوم السبت، ومع ذلك فهي تنجح في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
في ظل العيش في بلد لغته الرسمية الإنكليزية والفرنسية، ما الذي يعنيه لك أن تدرّس العربية ليوم واحد في الأسبوع. هل هو فعل مقاومة ثقافية أم وسيلة للاندماج بشكل متوازن؟
في إحدى المرات، أجريت مقابلة مع أخصائية نفسية متخصصة في علم النفس اللغوي (psycholinguistics)، وقالت لي إن تعلّم الطفل للغته الأم أمرٌ بالغ الأهمية في بناء شخصيته، فاللغة الأم (langue maternelle) تلعب دورًا أساسيًا في تكوين الهوية الفردية.
هذا الأمر لا يقتصر على الجاليات العربية فقط، بل نلاحظه لدى الطليان، والصينيين، واليونانيين أيضًا. فكل الجاليات تهتم بالحفاظ على لغتها وثقافتها، لأنها ترى في ذلك حفاظًا على إرثها وهويتها.
ومن هذا المنطلق، بالإضافة إلى كونه حقًا طبيعيًا، فإن من حق الطفل أن يتعلم لغة أهله. وإذا قرر لاحقًا ألا يتحدث بها، فذلك خياره، لكن من واجبنا كأهل ومربين أن نمنحه هذه الفرصة وهذا الحق.
أذكر أيضًا موقفًا حدث مع ابني عندما كان صغيرًا، إذ سألته معلمته في المدرسة: "هل تتحدث الفرنسية؟"، فأجابها: "أتحدث الفرنسية والعربية." فقالت له: "أوه، أنت محظوظ!" وهنا أقول: إذا كان الإنسان يملك هذه الميزة، فلماذا يحرم ابنه منها؟ بل على العكس، هذا يُعد إثراءً حقيقيًا. فالطفل حين يتعلم لغة أخرى، يكتسب معها ثقافة إضافية.
وأضيف إلى ذلك قناعة نؤمن بها، وهي أن تعلّم اللغة العربية يسهّل كثيرًا فهم الدين.
فنحن دائمًا نقول إن مدرسة أجيال ليست مجرد مدرسة لتعليم اللغة، بل هي أوسع من ذلك بكثير. ومن خلال تجربتنا، اكتشفنا أنه كلما أُتقنت اللغة العربية بشكل جيد، كلما اتّضحت المفاهيم الدينية بشكل أعمق. ونظرًا لأننا بيئة تُولي أهمية خاصة للجانب الديني، فإننا نحرص على أن نوصل هذا الجانب للأبناء. فعندما أعلّم ابني الصلاة، لا بد أن أبدأ بتعليمه اللغة العربية، لأن ذلك يُسهِّل عليه فهم بقية المفاهيم الدينية بشكل صحيح.
تعليم اللغة العربية في كندا، هو أكثر من مجرد تعلم القراءة، هو دور تلعبه المدرسة في ربط الأجيال الجديدة بجذورها الثقافية واللغوية، وجعل الطلاب يتمسكون بهويتهم العربية، هل ترين أن مفهوم الهوية العربية في المهجر له دلالاته التي لا يلحظها المقيم في لبنان؟
نحن نعيش اليوم في زمن منفتح على كل شيء، ووسائل التواصل الاجتماعي باتت تنشر كمًّا هائلًا من المحتوى المتنوع. وأصبح هناك نوع من الفضول لدى الإنسان المقيم في هذا البلد لمعرفة كيف يفكر الناس في بلاد أخرى، فيبدأ بالبحث والسؤال.
وهنا يأتي دورنا في تسهيل هذا الطريق له؛ نساعده على معرفة أين يبحث، وكيف يكوّن رؤيته، لنمنحه في النهاية القدرة على اتخاذ قراره بنفسه. صحيح أننا نُلزم أبناءنا بتعلّم اللغة العربية، ولكننا، في المقابل، نفتح لهم آفاقًا أوسع ونمنحهم خيارات إضافية.
مسألة الارتباط بالهوية مهمة جدًا، فالكثير من الأطفال يشعرون بالضياع لأنهم يفتقدون الإحساس بالانتماء. ونحن نعمل على تعزيز هذا الجانب في شخصيتهم، فنقول لهم: "اعرف أصلك وتاريخك، وعلى هذا الأساس ابنِ مستقبلك."
تعليم العربية يظل في الهامش كمبادرة أهلية، من خلال تجربتكِ في الإدارة، كيف تتفاوت دوافع الأهل لإرسال أبنائهم إلى هذه المدرسة؟ هل هي بدافع الحفاظ على الهوية؟ الدين؟ التواصل مع الأهل؟ أم مجرد أداة وظيفية؟
في البدايات، كان هناك نوع من الحذر أو التردد لدى الأهالي في إرسال أبنائهم إلى المدارس العربية. لم يكونوا يعرفون تمامًا ما الذي يمكن أن تقدمه هذه المدارس. بعضهم لم يكن يتابع أو يهتم إذا تعلّم أبناؤهم أو لم يتعلّموا.
لكن الآن، الوضع تغيّر. أصبحوا يرَون تعليم اللغة العربية كمادة أساسية، لا تقلّ أهمية عن الرياضيات، أو التاريخ، أو الجغرافيا، التي يتعلمها أبناؤهم في المدارس النظامية. وهذا الوعي ساعدنا كثيرًا في الاستمرار كمدرسة.
قلت في كلمتي منذ قليل: نحن نريد أن نكون مدرسة "متابِعة ومتابَعة". متابِعة من قِبل الأهل الذين يتفاعلون معنا، يسألون، يناقشون، ويُقيّمون. وهذا بحدّ ذاته يعكس تغيّر الجو العام وتطوّره. ومتابَعة، بمعنى أننا نطوّر أنفسنا باستمرار ونتقدّم.
أما عن تجربتي، فمنذ أكثر من ست أو سبع سنوات وأنا أحرص على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على ما نقوم به. أردت أن أُظهر للناس أن أبناءهم لا يأتون إلى المدرسة فقط لتلقي المعرفة بأسلوب تقليدي. كما ذكر الشيخ علي منذ قليل، التلقين هو آخر ما نلجأ إليه. فنحن نحرص دائمًا على أن ترافق الدروس أنشطة تطبيقية عملية، لأننا اكتشفنا أن هذا ما يثير حماس الأطفال، ويجعلهم ينجذبون إلى المدرسة العربية.
كما أننا نحرص على أن يعرف الأهل ما يحدث داخل الصفوف. ولهذا السبب، لدينا أشخاص متخصصون في التصوير والمونتاج، ينقلون التفاصيل للأهالي. هدفنا أن نقول لهم: "ابنكم جاء إلى المدرسة ليتعلم، فها هو أمامكم، تعرّفوا إلى ما تعلمه." نحن نؤمن بأن التعاون بيننا وبين الأهل هو الأساس.
ما هي التحديات التي تواجهكم في تدريس اللغة العربية؟
الصعوبة الأساسية التي نواجهها هي أن دوام المدرسة العربية يقتصر على يوم واحد فقط في الأسبوع. وعندما يعود التلميذ في الأسبوع التالي، يكون قد نسي جزءًا كبيرًا مما تعلمه، فنضطر إلى إعادة الشرح مرارًا وتكرارًا. هذا التحدي اعتدنا عليه مع الوقت، وصرنا نلاحظ مدى قدرة الطفل على الاحتفاظ بالمعلومة، وكم تدوم في ذاكرته. وهكذا بدأنا نفهم الإيقاع، ونتعلّم كيف نسرّع أو نبطئ حسب الحاجة.
إضافة إلى ذلك، هناك إشكالية تتعلق ببعض الأهالي الذين لا يعيرون هذا الموضوع اهتمامًا كافيًا، فيتذكرون في وقت متأخر أن يُحضروا أبناءهم إلى المدرسة العربية. هذا التأخير يربكنا في عملية تنظيم الصفوف.
وبطبيعة الحال، نحن نُقسّم الصفوف بحسب الفئة العمرية، لكن في بعض الأحيان نواجه تفاوتًا في الأعمار داخل الصف الواحد، وقد يصل الفرق إلى سنتين أو ثلاث سنوات. وهنا تبرز أهمية ديناميكية المعلمة وقدرتها على إيصال المعلومة لكل المستويات: الكبير والصغير، الضعيف والقوي. وهذا يتطلب جهدًا مضاعفًا من المعلّمة كي تتمكن من إيصال المادة بشكل فعّال للجميع.
كيف يتم إعداد المناهج؟
من حيث المنهاج، فنحن نجلبه من لبنان، وأنا من المؤيدين لهذا الخيار. أشعر أن المنهاج القادم من الوطن الأم أكثر أصالة وقوة. صحيح أن البعض قد يعترض بأن بعض نصوص القراءة تتناول مواضيع لا يعيشها أولادنا هنا، كأن يُقال إن الشتاء في كندا ليس كشتاء لبنان.
وأنا أقول: لا بأس! ليس هناك مشكلة. مفهوم الشتاء الكندي يتعلمه الطفل في المدرسة النظامية هنا، أما نحن فنفتح له نافذة أخرى يرى من خلالها تراثه. عندما يسمع عن أجداده الذين كانوا يتعلمون تحت شجرة السنديان، ربما يبدو ذلك جديدًا عليه، لكنه يقرّبه من ماضيه ويُعرّفه إلى بيئة أهله.
أنا أعمل على تقوية مخزونه الثقافي، وأحرص على إثارة فضوله لكي يبحث ويستكشف. ولذلك أؤمن بأن المنهاج القادم من الوطن الأم أعمق وأغنى من حيث المحتوى الثقافي، حتى وإن كان المنهاج المحلّي يُسرّع عملية القراءة والكتابة.
لكن في نهاية المطاف، ما يهمّني هو الثقافة، لأنها ما يصنع الهوية ويمنح الطفل جذوره.
هل هناك طلاب من أصول غير لبنانية، وإذا كان من وجود لتنوع في الخلفيات هل يشكل إضافة أم تحديًا في مكان ما؟
بصراحة، مدرستنا بحكم موقعها الجغرافي تستقطب في الغالب أبناء البيئة اللبنانية. أنا لا أحب استخدام مصطلح "الجالية"، بل أفضّل أن أسميها "البيئة"، لأننا بتنا اليوم نشكّل مجتمعًا قائمًا بحد ذاته. لدينا حضور بسيط من الإخوة المغاربة والجزائريين، وهناك عائلة سورية تشاركنا كذلك، لكنهم يُعتبرون أقلية ضمن المدرسة.
نحن بالطبع نرحّب بالجميع، ولكنني دائمًا أكون صريحة مع الأهل الذين يزوروننا. إذا كان الطفل في سن صغيرة، فلا توجد مشكلة أبدًا في أن يبدأ معنا، وغالبًا تسير الأمور على ما يرام.
أما إذا كان الطفل قد كبر في السن، فسيواجه على الأغلب صعوبة في فهم اللهجة. وذلك لأننا، في الصفوف، نعتمد في الشرح على اللهجة اللبنانية إلى حدّ كبير، مع إدخال الفصحى بشكل جزئي فقط. والسبب في ذلك أننا لا نملك الكثير من الوقت، فمدة الحصة الأسبوعية أربع ساعات فقط، ولدينا كمّ من المعلومات نحرص على إيصالها بطريقة يفهمها الطفل بسرعة، وتكون اللهجة اللبنانية أقرب إليه في هذا السياق.
حين يأتي إلينا طلاب من جنسيات أخرى كالمغاربة، يواجهون بعض الصعوبات في فهم اللهجة، رغم إعجابهم بأسلوبنا التعليمي. ونحن من جهتنا نحاول دعمهم ومساعدتهم قدر المستطاع.
لكن في العموم، المجتمعات الجزائرية والمغربية تمتلك مدارسها الخاصة، وهي مؤمّنة من حيث التنظيم والمحتوى، وبالتالي لا نشعر بوجود أزمة حقيقية في هذا الجانب.
هل تلحظون وجود فجوة بين ما يتعلمه الطالب في هذا اليوم العربي، وما يعيشه بقية الأسبوع في محيط لغوي وثقافي مختلف كليًا؟ وهل تلاحظين تأثيرًا لهذه الفجوة على نظرة الأطفال لهويتهم العربية؟
نحن نشعر، إلى حدّ ما، أننا نجيب عن أسئلة تشغل بال الطلاب. فبالنسبة لنا، يُمثّل يوم السبت مساحة نخصصها للإجابة عن التساؤلات التي تراودهم، أو عن المواقف التي يعيشونها خلال أيام الدراسة العادية في المدارس الكندية. ولهذا السبب، أؤكّد لكِ أن البُعد الثقافي في مدرستنا مهم للغاية، وكذلك البُعد الديني، حيث نوليه اهتمامًا كبيرًا.
حتى الكادر التعليمي لدينا، من معلمات ومربيات، يخضع بشكل دائم لدورات تربوية مستحدثة، كما يشارك في نشاطات ثقافية تساعده على تطوير معارفه. الهدف من ذلك هو أن يكون مؤهَّلًا للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها التلاميذ، خصوصًا تلك التي يستقونها من محيطهم الخارجي.
كيف ترين العلاقة بين تعليم اللغة العربية والاندماج في كندا؟ هل تعلّم العربية يعزّز الانغلاق وشعور الطلاب بوجود تفاوت بينهم وبين الآخرين في المجتمع الكندي، أم أنه بالعكس يعمّق الجذور بطريقة تساعد على الاندماج الواعي؟
مسألة أن تعلّم اللغة العربية يعزّز الانغلاق هو خطأ شائع نقع فيه كثيرًا. إذ من غير الصحيح الاعتقاد بأن تعريف الطفل بلغته الأم وبيئته الدينية يشكّل عائقًا أمام اندماجه في المجتمع الكندي. هذا مفهوم خاطئ يعتمده بعض الأهالي، ونحن نبذل جهدًا كبيرًا، ليلًا ونهارًا، لتصحيح هذه الفكرة من خلال ما نقوم به في المدرسة.
على العكس تمامًا، كلّما كان الطفل متمسّكًا بلغته الأم ومطّلعًا على علوم دينه، كان أكثر قدرة على الاندماج في المجتمع الكندي. لأنه حينها يصبح قادرًا على تقديم ما تعلّمه من ثقافته الأصلية للبيئة التي يعيش فيها، بأسلوب إيجابي وسلس، يُسهم في تصحيح الكثير من المغالطات التي يسمعها من حوله.
* الصور من صدى أونلاين

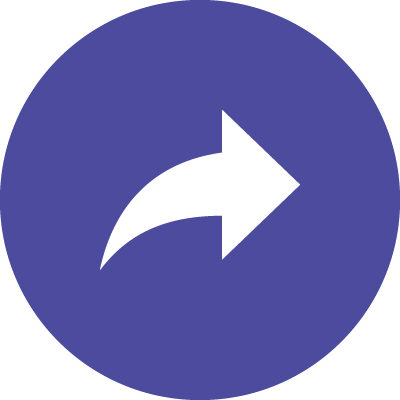














521 مشاهدة
24 يونيو, 2025
407 مشاهدة
05 يونيو, 2025
496 مشاهدة
18 مايو, 2025