دارين حوماني ـ مونتريال
سمر طارق فنانة تشكيلية عراقية، هاجرت إلى مونتريال في العام 1998، وعلى الرغم من تخصصها في الصيدلة، إلا أن الفن بالنسبة إليها موجود ومكرّس بالفطرة. شاركت الفنانة التشكيلية سمر طارق في العديد من المعارض الفنية في كندا كما أقامت معرضًا منفردًا، وفازت لوحتها "عناصر وأشكال تراثية" بجائزة معرض الفنانات العربيات في مونتريال.
في لوحاتها يتحاور التراث العراقي مع الخيال، وتتمازج الألوان في انسيابية تبحث عن الجمال والهدوء النفسي. ترى أن الواقعية هي أساس أي فن حقيقي، وأن الفنان لا بد أن يُتقنها قبل أن يبحر في عوالم السريالية أو التجريد. هي فنانة تحمل العراق في ذاكرتها، تستعيد الملوية والقباب العباسية، وتُجسّد الفلاح والفلاحة العراقيَيْن، كما تستحضر المرأة دائماً كصورة للذات والتمرد والجمال.
إلى جانب ريشتها، كتبت طارق في الصحافة الثقافية عن تغيّر الهوية المعمارية البغدادية وعن الفن التشكيلي العالمي والكثير من الموضوعات في مجلات عربية في كندا وأميركا. وهي تؤمن أن الذكاء الاصطناعي سرقة وأن الإبداع يولد من جهد الفنان وصبره.
هنا حوار معها عن حياتها مع الفن التشكيلي ورؤيتها للفن والتراث والمرأة والتحولات التي جرت على العراق.
***
حدّثينا عن بداياتك في العراق؟
أنا في الأصل من جنوب العراق، من البصرة والعمارة، أي من المحافظات الجنوبية، لكنني وُلدت ونشأت طوال حياتي في بغداد، إذ انتقل أهلي من الجنوب إلى العاصمة بسبب ظروف عمل والدي، وكنت آنذاك صغيرة.
كنت طالبة متفوقة جدًا، معروفة بين إخوتي بجدّي واجتهادي. نحن عائلة صغيرة نسبيًّا، لكنني كنت دائمًا الأكثر تفوقًا بين البنات بل حتى على إخوتي الذكور.
أكملت دراستي الثانوية في "مدرسة الرسالة" في منطقة المنصور، وهي من المناطق الراقية في بغداد. وكان معدلي في الصف السادس العلمي مرتفعًا جدًا يؤهلني لدخول كلية الطب، لكن والدي كان يعمل في مجال الصيدلة، وأخي الأكبر درس الطب، فرأى والدي أن الصيدلة أنسب لي كأنثى، فدخلت كلية الصيدلة.

لماذا اخترتِ دراسة الصيدلة بدل الفنون التشكيلية، رغم حضور الفن القوي في حياتك منذ وقت مبكر؟ وكيف كانت بداياتك مع الألوان؟
بما أنني كنت متفوقة في دراستي، فقد فضّل أهلي، بحكم تفكير الجيل القديم، أن أتوجه إلى التخصصات العلمية، معتبرينها أكثر وجاهة واحترامًا في المجتمع، وأفضل من المجالات الأدبية أو الفنية. وهذا برأيي خطأ كبير، ولم يعد هذا التفكير صحيحًا في أيامنا هذه.
مع ذلك، كان لدي منذ طفولتي ميول أدبية وفنية واضحة. فقد كنت أحب اللغة العربية كثيرًا، وكنت من المتفوقات فيها على مستوى المدرسة كلها. بل إنني حصلت على أعلى درجة في مادة اللغة العربية على مستوى مدينة بغداد، حيث نلت 93 من 100، وهو أمر نادر جدًا، وقد كرّمتني وزارة التربية آنذاك على هذا التفوق.
أما في البيت، فقد كنت رسّامة العائلة. أي عمل يحتاجه إخوتي بالرسم كنت أتولاه، مستخدمة أدوات بسيطة مثل الأقلام الرصاصية والفحم والألوان الخشبية. أما الألوان الزيتية والأكريليك فجاءت لاحقًا. كنت دائمًا أبدع لهم لوحات ورسومات صغيرة، وكان هذا جزءًا من هواياتي.
وفي أثناء دراستي في كلية الصيدلة بجامعة بغداد، افتُتح مرسم في الطابق الثاني من الكلية. وكان هناك أستاذ للرسم، وكانت تُتاح لنا فرصة الرسم إما في فترة الاستراحة بين المحاضرات أو بعد انتهاء الدروس والمختبرات في المساء. كنت معروفة بين الطلبة بحبي للرسم، حتى إنني كنت أشجع زملائي على المشاركة، وأتذكر أنني اشتريت لوحتين من أحد الزملاء الفنانين الصيادلة بمبلغ ثمانية دنانير في ذلك الوقت، وكان ثمنًا مرتفعًا.
حتى إن زملائي ما زالوا يذكرون ذلك، ويقولون لي عبر مجموعات التواصل: "لا ننسى أنك كنتِ أكثر من يدعم المرسم"، وقد أهداني بعضهم لوحات تذكارًا، تقديرًا لكوني من أكثر الطالبات حضورًا وترددًا على المرسم.
ومع مرور الأيام، أكملت دراستي، ثم تزوجت، وأصبحت أمًّا لثلاثة أبناء. وبقيت في العراق فترة خلال الحرب العراقية–الإيرانية، قبل أن تبدأ ظروف السفر والتنقّل لاحقًا.
ما الذي مثّلته لكِ الهجرة إلى كندا، هل كانت بحثًا عن الأمان، أم عن الفرص الأكاديمية والمهنية؟
جئتُ إلى مونتريال أول مرة عام 1984، كطالبة دراسات عليا في جامعة كونكورديا، تخصّص الأحياء الدقيقة السريرية (Microbiology Non-Clinical) قبل ذلك قضينا فترة في أبوظبي بسبب الحرب العراقية – الإيرانية، ثم عدتُ إلى العراق، أنجبت أولادي الثلاثة؛ بعضهم وُلد في كندا أثناء دراستي، والبعض الآخر خارجها.
أكملت دراستي وتعلمت اللغة الفرنسية، . وبعد فترة، رجعت مرة ثانية عام 1995 كمهاجرة مع عائلتي، إذ كانت كندا بحاجة إلى صيادلة، وقدمتُ طلب الهجرة بصفتي المتقدّمة الأساسية (Applicant) في ذلك الوقت كان الحصول على الهجرة أمرًا صعبًا جدًا، فقد كانت مشروطة بإنشاء مشروع استثماري. بالفعل أنشأت مشروعًا طبيًا صغيرًا لرفع الشرط والإقامة الدائمة.
وفي عام 1998 قررت الاستقرار نهائيًا في كندا دون العودة للتنقل بين الشرق الأوسط وكندا.
ما الأثر الذي تركته فيكِ هذه الهجرة كفنانة؟
انفتحت موهبتي الفنية بشكل كبير. أول ما شاركتُ كان في معرض لجمعية "Le Levant" في مونتريال، مع السيدة نسب شيا، ومنذ ذلك الوقت شاركتُ في معارض عديدة وراقية. كان يحضر معارضنا كبار الشخصيات، مثل وزير الخارجية الكندي آنذاك ستيفان ديون، ولدي صور معه. كما أقمت أول معرض شخصي لي في "سان سوفير" لمدّة أربعة أيام، حضره عراقيون مغتربون من مختلف أنحاء العالم، وقد عرضت فيه أكثر من ستين لوحة، وكان ناجحًا جدًا.
أقمت معارض عديدة، منها معرض للفنانات العراقيات في المركز الثقافي المغربي، وقدّموا لنا القاعة مجانًا دعمًا للثقافة. اشتركنا خمس فنانات عراقيات، وكانت لكل واحدة خمس أو ست لوحات.
كما شاركت في معارض بمونتريال منها معرض عام 2019 قبيل جائحة كورونا.

ما سبب عدم وجود ثقافة شراء الأعمال الفنية في الوسط الثقافي العربي في كندا؟
بالنسبة لي، أنا لا أميل كثيرًا لبيع لوحاتي، لذلك نادرًا ما أبيع. عادةً أحتفظ بالأعمال الأصلية (Masterpieces)، وأحيانًا أرسم نسخة مشابهة بيدي، لكنها تبقى مختلفة عن اللوحة الأصلية.
إلى أي حد كان لكِ تواصل أو تعاون مع الفنانين الكنديين، وهل ساعدك ذلك على إدخال عناصر جديدة إلى تجربتك أو على رؤية الفن من منظور مختلف؟
نعم، كان لدي تعاون كبير مع فنان نحات كندي اسمه جيري، وهو من كبار النحاتين في كندا، وحاز على جوائز مهمة، ومن أعماله الكبيرة نحت "الكانو" canoe الذي كان يستعمله السكان الأصليون. تعاونت مع شركته كثيرًا، بل يمكن القول إني ساعدتهم أكثر مما ساعدني، إذ عرّفتهم على المجتمع العربي، ورافقتُهم في أبوظبي ضمن فعالية ثقافية استمرت أسبوعًا تحت عنوان "أيام التراث الكندي".
من خلال زياراتك للمعارض الفنية الكندية، كيف ترين الفارق بين الفنانين الكنديين والفنانين العرب؟
زرتُ كثيرًا من المعارض هنا. الناس في العموم لا يحبون الفن المعاصر كثيرًا، مع أنني أعشقه. البعض يظنّه مجرد ضربات فرشاة عشوائية، لكن هذا غير صحيح. فالفنان الحقيقي، مثل "ريوبيل" الكندي الذي زرت معرضه، يبدأ بالمدرسة الواقعية، ثم ينتقل إلى الأسلوب الحديث أو السريالي.
أنا منذ وصولي إلى مونتريال انتميت إلى متحف الفنون الجميلة (Beaux-Arts) وكنت أجدّد اشتراكي باستمرار. هناك تتبعين مسار الفن عبر العصور: من الواقعية في القرون 15 و16 و17، مرورًا بالمدرسة الانطباعية، وصولًا إلى الفن المعاصر. الفنانون الكنديون مبدعون جدًا، لكنني أرى أن الفنانين العرب يتميزون باختلاف الأفكار وتنوّع الألوان وجرأة التراكيب، ولدينا فنانون ممتازون بالفعل.
هل شاركتِ في معارض بالعراق أو في الدول العربية؟
حتى الآن لم أشارك، لكن هناك مشروع قريب. أقمتُ مؤخرًا معرضًا للجالية العربية هنا في كندا، بدعوة من "مركز الوازير"، حيث وقع الاختيار على لوحاتي لتُعرض ضمن أمسية عن الجمال والمحبة، بتنظيم الجمعية الكندية العراقي وصالون هتاف الثقافي تم اختيار لوحاتي لأنهم رأوا أنها تعبّر عن الهدوء النفسي والجمال والألوان المريحة والانسيابية. حاليًا نحضّر لمعرض مهم جدًا، لا أريد أن أذكر تفاصيله الآن، لكن سيشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات العراقيين.
كيف تصفين أسلوبك الفني بعد هذه السنوات من التجربة؟
لوحاتي تنتمي إلى المدرسة الواقعية. فأنا لا أؤمن بالفنان الذي يدّعي الرسم السريالي من دون أن يتقن الواقعية أولًا. جميع الفنانين الكبار، قديمًا وحديثًا، بدأوا بالواقعية، ثم انتقلوا إلى السريالية أو غيرها من المدارس.
أنا أحب أن أنطلق من الواقعية، ثم أضيف لمسات تشكيلية، أي خيالية، تنقل المشاهد إلى عوالم لونية جديدة، قد تكون غير واقعية تمامًا. كتبتُ أيضًا مقالات عديدة في الفن التشكيلي ونشرتها.

إلى جانب الرسم، لكِ حضور في مجال الكتابة الصحافية الثقافية. كيف بدأتِ هذا المسار، وما طبيعة الموضوعات التي تكتبين عنها؟
نعم، لي نشاط واسع في هذا المجال. اشتركتُ في مجلات ثقافية متعددة. لدي موقع خاص بالفن التشكيلي في مجلة تجمع منتدانا الثقافي"، وأصدرت أربعة أعداد، كتبت فيها عن الباليه والأوبرا والموسيقى الكلاسيكية، كما تناولت لوحات لفنانين عالميين بالشرح والتحليل.
نشرتُ أيضًا في مجلة "غرفة 19" بإدارة السيدة إخلاص الفرنسيس في سان دييغو، وفي مجلة عراقية بريطانية تصدر في لندن عراقية – لبنانية، كانت تديرها الأستاذة مي عيسى والدكتور علي حرب والأستاذ أسامة أبو شقرا.
أحب أن أعرّف الناس هنا على أعمال فنية عالمية وعلى تاريخ الفن، وقد وجدت في هذه المجلات الثقافية فسحة للكتابة عن ذلك.
أي فنانين عالميين شعرتِ أنهم الأقرب إليك فكريًا وجماليًا، وكيف ساعدتك أعمالهم على بلورة هويتك الفنية الخاصة؟
من أبرز من أحببت أعمالهم: سيزان، من المدرسة الانطباعية، ثم غوستاف كليمت، المحدث وصاحب لوحة "القبلة" الشهيرة، وقد كتبت عنها مقالة مطوّلة، كما رسمت لوحة عن "القبلة" لفلاح وفلاحة عراقيين. يعجبني بكليمت إدخاله للألوان المذهّبة، مع ألوان نابضة مثل البرتقالي والأزرق.
كذلك أحببت رينوار، الذي بدأ بالواقعية ثم مزجها بالتعبيرية، وأيضًا مونيه بلوحاته الضبابية المميزة. هؤلاء الفنانون تركوا بصمة كبيرة في تجربتي. وبالطبع، لدينا في العراق أيضًا فنانون كبار.
هل تابعتِ تحولات الفن التشكيلي في العراق؟
نعم، منذ صغري كنتُ حريصة على زيارة كل معرض أسمع عنه، سواء في الكلية أو خارجها. كانت لي صديقات في أكاديمية الفنون الجميلة، وكنت أرافقهن باستمرار. عرفتُ عن قرب أسماء كبيرة في التشكيل العراقي: النحات فائق حسن، خالد الرحال، وجواد سليم، الذي نحت نصب الحرية في بغداد، وهو من أعظم الأعمال الرمزية التي تمثل ملحمة العراق. كذلك ضياء العزاوي وغيرهم كثير.
عندما زرتِ العراق بعد سنوات طويلة من الهجرة، ما التغييرات التي شهدها العراق؟
منذ صغري تعودت مع عائلتي، رغم أننا عائلة علمية يغلب عليها الطب والهندسة، أن نزور المتحف العراقي والمعارض الفنية بشكل دائم، عائلتي تقدّس الفن. بالنسبة لي، كان أول ما أفعله عند العودة إلى بغداد هو زيارة المتحف العراقي. هذا المتحف كنز حقيقي؛ يضم آثارًا من الحضارات الأكادية والسومرية والبابلية والآشورية، وصولًا إلى العصور الإسلامية والحديثة. رأيت فيه بعيوني روائع مثل القيثارة السومرية والتماثيل الذهبية والسبائك الأصلية.
لكن المؤلم أن هذه الكنوز سُرقت بعد عام 2003. آلاف القطع الأثرية نُهبت، بما فيها المكتبة السومرية التي احتوت ألواحًا طينية بالكتابة المسمارية، هي أقدم القوانين الإنسانية في التاريخ، سبقت حتى مسلة حمورابي. حمورابي أول من وضع قوانين للبشرية، كانت قوانين تنظم الحقوق والجرائم والزراعة والملكية. وكذلك سُرق التاج السومري.ففُتحت لهم أبواب المتحف..
خلال زيارتي عام 2018، رأيت أجنحة كاملة خالية، لكن لحسن الحظ هناك صور فوتوغرافية محفوظة للأعمال المنهوبة. ومع ذلك يبقى الألم كبيرًا، لأن ما فُقد ليس مجرد آثار، بل هو تاريخ الإنسانية جمعاء.

بين الواقع والخيال، والذاكرة واللون… ما الموضوعات التي جذبتك أكثر لتجعليها محورًا للوحـاتك؟ وهل يشكل التراث العراقي أحد المحاور الأساسية التي سعيتِ إلى تجسيدها فنياً؟
نعم، بالتأكيد. بدأتُ بهذا الاتجاه منذ سنوات، وأنا الآن أعمل على لوحة جديدة تحضيرًا لمعرض قريب. لدي لوحة تراثية عن الأيقونات العربية، خاصة العباسية، ولوحة أخرى مقتبسة من "القبلة" لكن بصياغة عراقية، حيث رسمتُ فلاحًا وفلاحة من الريف العراقي.
كما أنجزت لوحة لامرأة تحمل شمعة تدعو للسلام. هذه اللوحة مؤلمة بالنسبة لي، فقد استوحيتها بعد القصف الذي أصاب منطقة الملوية في سامرّاء، وهي من أعظم الآثار العباسية،. أردت أن أُدخل في اللوحة صرخة سلام ورجاء أن يتوقف سفك الدماء.
أميل إلى الواقعية المزينة بالتشكيل، فأرسم الواقع ثم أُدخِل فيه عناصر خيالية أو تراثية. إلى جانب لوحة "القبلة" العراقية، عندي لوحات تستلهم أبواب العراق القديمة، والسماوات العباسية، وصور النساء العراقيات.
كما أنجزت لوحة فيها مئتا وردة، وأخرى بعنوان "أشكال ورموز عربية" فيها عناصر تراثية عراقية فازت في معرض للفنانات العربيات هنا في كندا، وتم اعتماد إحدى لوحاتي بعنوان "الجذور" كملصق رسمي
الألوان في أعمالك تتحدث بصوتها الخاص. كيف تختارين الألوان لتعبّر عن مشاعرك أو رسالتك الفنية، وهل تمثل بعض الألوان رمزية محددة لديك؟
أحب أن تكون الألوان متداخلة ومتوازنة، حتى وإن بدت صارخة. بدأت بالألوان المائية، مستخدمة تقنيات مثل "Glazing watercolor" التي تسمح بانسياب الألوان تلقائيًا، وكذلك تقنية القصبة. ثم انتقلت إلى الأكريليك وأحيانًا أطعّمه بالزيت.
كما أستخدم أحيانًا تقنية الصمغ مع الألوان، وهي تمنح تدرجات لونية جميلة ومدروسة..
مع صعود الذكاء الاصطناعي في عالم الفنون، كيف تنظرين إلى هذه الظاهرة؟ هل هو اختصار للوقت يفتقد الروح، أم فرصة لتوسيع حدود التعبير الفني؟
لا أحبه إطلاقًا. أعتبره دخيلًا على الفن وسرقة لجوهر الإبداع. اللوحة الحقيقية قد تحتاج من الفنان شهرًا كاملًا من العمل والتأمل، بينما يعطيك الذكاء الاصطناعي نتيجة خلال نصف ساعة عبر برنامج آلي.
الفنان الحقيقي، الواثق من نفسه، لا يمكن أن يلجأ إلى هذه الطرق. وأنا من هؤلاء: أبدأ اللوحة من الصفر وأكملها بيدي حتى النهاية.
المرأة حاضرة بكثرة في لوحاتك، لماذا هذا التركيز عليها، وما الذي تمثلّه لك كرمز أو كموضوع فني؟
لأنني امرأة أولًا، وأحب أن أعبّر عن ذاتي وعن عالمي الأنثوي، وأحب المرأة المتمردة. أحب أن أُظهر المرأة في أجمل صورة، بزينتها وأناقتها. هذه التفاصيل الدقيقة لا يعرفها الرجل كما تعرفها المرأة. لذلك، في معظم أعمالي تكون المرأة هي المحور، لأنها تمثلني وتعكس ذاتي. كما أحب أن أرسم الورود والطبيعة ووجود المرأة مع الرجل.

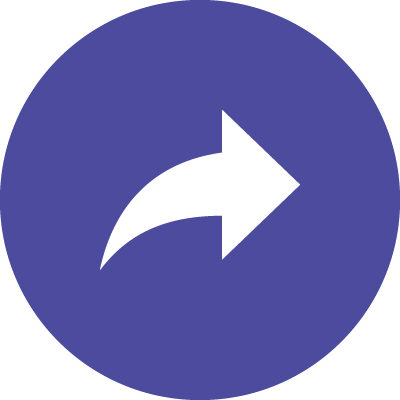








245 مشاهدة
24 أكتوبر, 2025
209 مشاهدة
24 أكتوبر, 2025
757 مشاهدة
12 أكتوبر, 2025